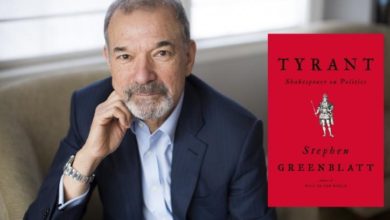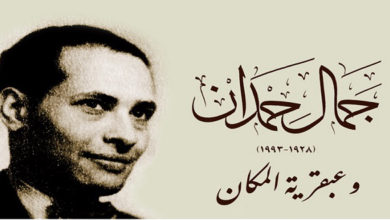الروائي والناقد الايطالي إيتالو كالفينو تحدث في كتابه «الخطوات الست للألفية القادمة»، حول التكثيف والسرعة والوقت والمكان، بإعتبارهم أدوات القصة القصيرة، التي قد لا تتعدى السطر الواحد. ورغم سطوة الرواية بشكل كبير على المشهد الأدبي الراهن، تتشبث أسماء قليلة بالقصة بأنواعها المختلفة وتراها المجال الأنسب لإبداعها، ومن تلك الأسماء القاصة السكندرية عبير درويش التي حصدت رواياتها القليلة العديد من الجوائز، ومنها جائزة نادى القصة، وجائزة “إحسان عبد القدوس” ، وأخيرا جائزة “صلاح هلال” العريقة في دورتها الدورة الخامسة عشر.
وكان لنا معها هذا الحوار.
هل تتفقين مع رؤية “كالفينو” عن مستقبل القصة القصيرة؟
القصة القصيرة جدًا جنس أدبي حديث، يمتاز بالإيحاء المكثف والرمزية المباشرة وغير المباشرة، بما يشملها من تلميح أو اقتضاب، أى الصفة الأساسية بها “الاختزال”، وأنا لست ضد أو مع القصة القصيرة جدًا، التي يميل إليها كثير من القراء هربا من القراءات الطويلة، وهناك من الكتاب أيضا من لا يتمتع بملكة التبحر في السرد، ويقتصد الفكرة والموضوع من باب السرعة ليقدم لنا “خاطرة” لا تصل بالقارىء إلى عمق درامى أو هدف ورؤية تتماشى مع الواقع المعاش. هذا النوع من الكتابة أراه امتدادًا طبيعيًا لبعض كتابات رواد السّرد، مثل “النديم” في مجلته “التنكيت والتبكيت” وجبران خليل جبران في كتابه “المجنون”، وكتابات نجيب محفوظ الأخيرة، وأنا مع أي شكل أدبي يحمل المتعة إلى القارئ، والقصة القصيرة جدًا فن صعب تحقيقه إلا لمن يملك أدواته الحقيقية.

إيتالو كالفينو
وكيف ترين الصورة الشعرية في العمل القصصي؟
الصورة الشعرية توظيف لغة جمالية “زخرفية” لا ينبغي الإسراف فيها حتى لا تطغى على عنصري الحكي والحبكة، وينبغي أيضا ألا نقطرها ونكتفي بالحكي “الجاف”، وإلا بدت الكتابة أقرب للتقريرية، فاللغة والتشبيه والصور الجمالية من عناصر نجاح السرد، وخير مثال “ماركيز” الذي أشادت لجنة جائزة نوبل بلغته الشاعرية، وهنا أود التطرق إلى خطورة دور الترجمة فى نقل الصورة الشعرية لأغلب الأعمال التي تصلنا معيبة ومائعة.
هل ترين وجاهة لاستخدام البعض مصطلح الأدب النسائي؟
أنا من أنصار النص الإنساني كائنا من كان كاتبه، ولو تم تخصيص جهد نقدي عربي حقيقي لدراسة نتاج الكتاب العرب من الجنسين وما طرحوه من قضايا تطال همّ الإنسان العربي، لاكتشفنا أن كليهما، الرجل والمرأة، يصارعان في دوامة المعاناة ذاتها، الحب والحرب والغربة وازدواجية المعايير الأخلاقية وفقدان الحرية في مجتمع التابوهات.
قصدية التهميش في تناول نصوص الكاتبات هي استمرار طبيعي لممارسات الواقع، وما الدراسات التي تتناول نصوص الكاتبات بالجملة لتنميطها وعزلها إلا صورة واضحة لرغبة في تكريس هذا التصنيف. مصطلح الأدب النسائي تصنيف معياره جنس الكاتب وليس ما يبدعه، وهو ينتقص من إنسانية الكاتب عندما يحدد انتماءه إلى أبناء جنسه، فليس هناك فرق بين إبداع نسائي وإبداع ذكوري، إن صح التعبير، إنما هنالك اختلاف في الرؤى عندما يتعلق الموضوع بحقوق وواجبات كل من الطرفين. لنقل مثلاً إن كاتبة وكاتبًا أرادا أن يكتبا قصة عن رجل يعيش علاقة حب خارج إطار الحياة الزوجية، من وجهة نظر الكاتب سيركز على تقصير الزوجة الذي دفع الزوج للبحث عن أخرى، من وجهة نظر الكاتبة ستنعته بالخيانة.
أما لو كان الموضوع وطنيًا أو أو اجتماعيًا أو حتى نفسيًا، لا أظن أن هناك اختلافًا سواء في الرؤية أو في الإبداع، لكن ربما أبدى الأدب النسائي إحساسًا مرهفًا أكثر من نظيره الذكوري، فيما يبدي الأخير جرأة أكبر في طرح المسائل العاطفية. أنا أعتمد الحس الإنساني في كتاباتي، بغض النظر عن التصنيف الذى يشغل عقول المقننين والمنظرين.
لدينا طابور طويل من كاتبات القصة القصيرة، رغم هجرة البعض إلى عالم الرواية؟
الطابور جد طويل، وهناك بالفعل أسماء كثيرة لامعة لكاتبات القصة القصيرة، تحققن وأثبتن جدارتهن واستحقاقهن في تصدر المشهد، مثل: عزة دياب، غادة العبسي، نسرين البخشونجي، سهير شكري، غادة هيكل، دعاء إبراهيم، هبة خميس، والقائمة تطول. أما عن هجر القصة للرواية فتلك قضية أخرى، فالمجتمع الأدبي ساهم في ازدراء القصة والتقليل من شأنها كصنف أدبى مستقل بذاته، فنجد الغالبية العظمى من النقاد والكتاب باتفاق ضمني غير معلن، لا يخلعون صفة الكاتب أو الأديب سوى لمن حاز شرف تجربة كتابة الرواية. ولا أعتقد أن بإمكان إحداهما أن تأخذ مكان الأخرى، فلكل منهما خصوصيته وجمالياته وفلسفته الخاصة وقراؤه، وبرغم شروعي في كتابة الرواية لكنني متيمة بهذا الفن الرفيع المسمى بالقصة.
هل ساهمت دراستك للسيناريو في صقل تجربتك الإبداعية؟
أنا أيضا أم وربة منزل وأمتلك مهارات وتجارب حياتية عديدة، ما أكسبني بعدا فلسفيا للأمور والأحداث والشخوص، فقط أقوم بالطرح على الورق بعدسة قلمي، وتأثير دراسة السيناريو ظهر جيدًا عندما قررت كتابة مجموعة قصصية بأسلوب “الكاميرا الوصف”، كان ذلك في مجموعتي الأخيرة “حدود الكادر”، وروايتي الأولى تحت الطبع، وهي رواية توثيقية استغرقت مني أكثر من عامين لجمع المادة، وأثمرت عن تحويلها إلى مسلسل إذاعي.

في قصتك الفائزة بجائزة نادى القصة، تعيش “حياة” وسط المقابر، هل عمدت إلى إظهار التباين في المعنى؟
أن يصلك المعنى يعني نجاحي في إصابة الهدف ووصول رسالتي، “حياة” سيدة تعيش بمقبرة السيد الضجر الذى لا يعيش “حياة”، المغزى للتبسيط وهو خاتمة القصة، لا يهم أين وكيف نعيش، الأهم أننا “قيد حياة”، وحياة هنا المعني بها السعادة.
وما جديد عبير درويش؟
هناك رواية تحت الطبع أعمل عليها وآمل أن تخرج للنور قبل نهاية 2019، وهي الرواية الأولى لي بعد أعمالي القصصية المنشورة، زهرة اللانتانا، تعاريج، حدود الكادر، طبق الدهشة.

هل افتقدت القصة القصيرة إبداع روادها الأوائل، حقي وإدريس ويحيى الطاهر عبد الله وغيرهم؟
ثمة حالة استمرأت شعار الزعيم الأوحد في كل المجالات، يوسف ادريس اشتهر بجرأته وبراعته في تصوير الواقع المصري، لكنه لم يكن بالقدر نفسه مجددًا في الأساليب الفنية أو أشكال القصة أو القدرة على المغامرة الفنية.
هل لديك طقوس خاصة بالكتابة؟
الكتابة حالة وجدانية تحتاج إلى هدوء وتركيز ولا يلزمنا في الكتابة أكثر من فنجان قهوة ومكان هادئ، ولكن الإبداع هو الحافز لسبر أغوار اللغة التي تمنح النص بريقه الحافل بالدهشة، لهذا تجدني دائمًا تحت وطأة الحالة التي تؤثر في مكامني، غارقة في طقوسي المعتادة التي أمارسها بين خلجات النفس واحتراق الروح تواصلا مع حرف يتسامى دائما في أوراقي لأصل إلى ما أتوخاه من الكتابة، وهو إيصال ما أشعر به إلى المتلقي، وهذه ليست طقوس بالمعنى المتعارف عليه بل أدوات توفر مناخ أفضل للكتابة.
لكن ماذا يحرضك على الكتابة؟
الشعر هو ما يحرضني على الكتابة، حالة فريدة تجرفني معها حين تشاء، أجد نفسي سائرة خلفها أحلق في عالم الحلم، الشعر هو الذي يكتبني في أغلب الأحيان، أما في مساحة القصة فأفضل الواقع لأني أجد في الواقع قصصًا غريبة لا بد من توثيقها مع إضفاء شيء من الخيال يتقبله المتلقي ويتفاعل مع الحدث، وأعتقد أنه هو المبدع الحقيقي لأنه يلهمني، أضف الموسيقى والسينما والمحبة فى عموم المطلق، من وكل البشر.
بمن تأثرتِ عبير درويش من الكتاب الأجانب والعرب؟
ربّما أثّرت إلى حد ما في أعمالي نصوص أخرى في علم الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا وميثولوجيا الشعوب وفولكلورها، فالفلسفة هي دراستي الأساسية، بالإضافة إلى السيناريو، وهذه العلوم تشكّل خلفية معرفيّة مهمّة للكاتب، لأنها تتداخل كثيرًا مع الأجناس الأدبية المعاصرة، ولا يمكن للنصوص الإبداعيّة الأولى أن تستقلّ عنها أو تنفصل، وأفدت منها إلى حد بعيد. قرأت بالطبع بعض أعمال مبدعين كبار، جورج لوكاش، رولان بارت، جوليا كريستيفا، جيرار جينيت، تزيفيتان تودوروف، جاك دريدا، ميخائيل باختين، أندريه ميكيل، ميتشيل بوتور، غاستون باشلار، وغيرهم، وساعدتني هذه النصوص أن أقرأ النص الأدبي وأفهمه بعيدًا عن أيّ أيديولوجيا خاصّة أؤمن بها أو أعتنقها.
جذبتني أيضا أعمال غابرييل غارسيا ماركيز، أندريه جيد، أرنست همنجواي، غي دو موبان، نيكوس كانتزاكيس، بلزاك واريك سيغال، هرمان ملفيل، جاك لندن، وألبير كامو، غوستاف فلوبير، أمبيرتو إيكو، تورجنيف، دوستوفسكي وآخرون. كما قرأت لكثير من كتّاب الرواية والقصة العرب، خاصّة الكتاب المغاربة، ومنهم: محمد برادة، رشيد بو جدرة، الطاهر وطّار، واسيني الأعرج، محمود المسعدي، رضوان الكوني، محمد العروسي المطوي، ولا أنسى كتاب الرواية والقصة القصيرة في مصر، فقد قرأت لمعظمهم، خاصة أعمال نجيب محفوظ، يوسف إدريس، يوسف القعيد، جمال الغيطاني, صنع الله إبراهيم، إدوارد الخراط, وغيرهم كثيرون.
مجموعتك الثانية “تعاريج”، هل تحمل شيئا من تجاربك الخاصة؟
البديهي أن يظهر الكاتب على الورق، بمفهوم أدق أن تقرأ شخصيته واتجاهاته وميوله، فالإنسان عادة تلامسه تجاربه الذاتية، تؤلمه، تفرحه، تبكيه، تصقله، وبالنهاية تؤثر في كل ما يصدر عنه، ألم يكتب نزار قباني عن تجاربه الشخصية، عن بلقيس، عن أوجاعه وغربته؟ ألم يكتب طه حسين “الأيام”؟ حتى مع وجود إضافات لمكونات العمل الإبداعى، فإن جميع ما يكتبه الروائي يرتبط بذاته ومن يعرفهم بشكل أو بآخر، لقد كان “استندال” يقول: “مدام بوفاري هي أنا”، ودستويفسكي يصف إحساسات المقامر، لأنه عرفها وخبرها بذاته.

المرأة أيضاً تكتب عن تجاربها الذاتية أو من خلال تجاربها، وقد تمتنع وتحتفظ بها لنفسها، هذا لا يمنع أنها تكتب باتجاهات أخرى بعيدًا عن تجربتها الشخصية، من خلال ذاتها الأنثوية الأكثر إحساسًا لأنها جزء من الوطن والمجتمع ومعاناة الناس من حولها. بالنسبة لي كانت مجموعتي الأولى خليطًا من هموم المجتمع وهموم الإنسان، وربما اقتربت أكثر من “عبير” الإنسانة في متتاليتى القصصية “تعاريج”، لكننى لم أبتعد بالقدر الكبير من عبير الكاتبة.
هل ترين فجوة بين الإبداع والنقد؟
النقد الأكاديمي الذي يقترب من الموضوعية والعلمية، ليس من مهمته أن يبرز عيوب النص وينقده ويسفه أطروحاته الفكرية، بل عليه أن يحلله ويشرحه ويفك استغلاقاته الرمزية والمبهمة، ويبين مدى تناصّه وتعالقه مع نصوص أخرى فكرية أو إبداعية، وأن ينهمك بأدواته المعرفية المتعددة في تشكيل قراءة جديدة غير عدوانية وغير شللية وغير إيديولوجية أو مذهبية سياسية، فالنص الإبداعي هو نص أول، أما النص النقدي فهو نص ثان، وليس من مهمة النص الأول أن يطوّع نفسه أو يلوي عنقه لرغبات النص النقدي ومعاييره، بل على الأخيرأن ينهمك بأدواته المعرفية وطرائقه المتعددة في فهم النص الأول ودراسة بنياته الفكرية والجمالية والفنية والتشكيلية. نستثني من ذلك بطبيعة الحال، النصوص التي لا تقول شيئًا، أو أن تضيف جديدًا على مستوى الرؤية والفكر والفن.
ماذا عن مشاركتك الأخيرة بملتقى الشارقة للسرد بالمغرب؟
سعيدة للغاية لمشاركتي بتلك الفعالية التي تعد رائدة في تفعيل الحراك الثقافي والأدب العربي، واستفدت كثيرا من مشاركتي في فعاليات الدورة الأخيرة التي عقدت تحت عنوان: “الرواية الجديدة.. تحولات وجماليات الشكل الروائي”، وساهم فيها كوكبة من نقاد وأدباء العالم العربي والمهجر أيضا، وشاركت بشهادة سردية في اليوم الختامي للفعاليات مع الكاتبة المغربية فاتحة مرشيد، وتم توثيق شهادات الكتاب المشاركين ومقالاتهم النقدية في كتاب ضخم صدر عن الملتقى.