في ذكرى مولد الحبيب محمد –صلى الله عليه وسلم– نتمثل سيرته ونحاول تلمّس هديه متبصرين العبرة من مواقفه مهتدين بثوابته التي أسّس بها لخيرية هذه الأمة، ورفع بها بناء دولته الركين.
لقد وضع الهادي البشير نُصب عينيه هدفا أسمى وغاية عظمى هي أن تقوم دولة الإسلام على أفضل ما تكون الدولة من القوة والمنعة في مواجهة أعدائها، وعلى خير ما تكون عليه الدول من وحدةٍ وتماسكٍ داخلي بتقوية الروابط بين أفرادها وإزالة الخلافات وتعميق القواسم المشتركة، ومحو الإحن من النفوس.
“مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ “(10) فاطر.
لقد كان منهجه صلوات ربي وسلامه عليه في بناء الدولة يقوم على أساس استلهام أسباب القوة بصورها الروحية والمادية معا، فكان بناء المسجد أول أعماله بالمدينة؛ فالتماس أسباب العزة لا يكون إلا بحبل الله المتين الذي له العزة جميعا، والمسجد مرتقى القلوب إلى ربها، ومجمع الأرواح في تقربها اليومي لخالقها، وهو مركز القيادة السياسية التي ستقود الدولة نحو تحقيق غاياتها في نشر الرسالة وإعلاء كلمة الله، ودحر المناوئين، كما جعله الرسول مقرا للقضاء تُسَوّى فيه النزاعات في جو من الرضا والقبول.
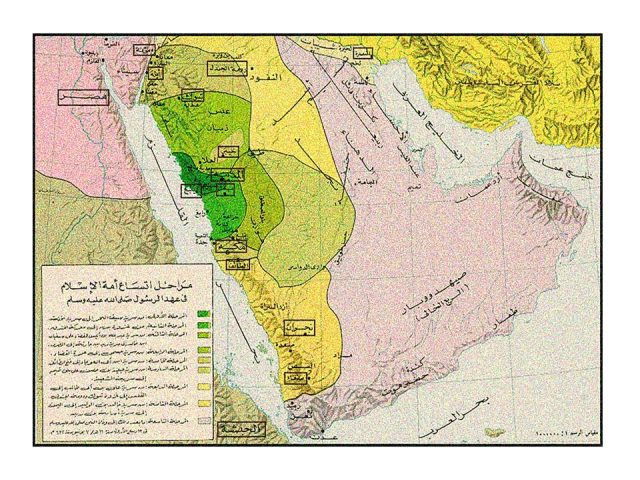
إن تنظيم الجبهة الداخلية والعمل على سلامة نسيجها من الضعف والتحلل؛ لهو من أوجب الأمور التي يلزم أن يلتفت إليها كل ساع إلى تلمس أسباب العزة.. وبنظرة سريعة إلى مجتمع المدينة عند بداية تأسيس الدولة؛ نجد تفاوتا كبيرا بين فئاته، وإذا استثنينا الجانب العقائدي سنجد أنهم أقرب إلى التفرق منهم إلى الاجتماع، فكانت المؤاخاة علاجا ناجعا أصلح به الرسول بين الأنصار أنفسهم –المؤاخاة بين الأوس والخزرج– وأعاد تقوية لُحْمَة المجتمع بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وجعل من المؤاخاة سبيلا إلى علاج المعضلة الاقتصادية التي نتجت عن انتقال المهاجرين إلى المدينة بغير أن يحملوا من أموالهم شيئا.. وتأكيدا على أهمية صيانة الجبهة الداخلية من الاختراق والتهلهل، عاهد الرسول الكريم يهود المدينة، وتضمن العهد معهم أنهم والمؤمنين أمة من دون الناس ” لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة (وثيقة المدينة) وإن بينهم النُّصح والنصيحة، والبرَّ دون الإثم، وإنَّه لا يأثم امرؤُ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا تُجَارُ قريشٌ ولا مَنْ نَصَرَهَا، وإن بينهم النصر على من دَهِمَ يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهُمْ، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم”.
ويتضح من تلك الوثيقة أن الرسول لم يترك أدنى ثغرةٍ من الممكن أن تنفذ منها أسباب الضعف والانهيار إلا واحتاط لها، برغم أن الدولة كانت ما زالت في طور النشأة إلا أن ذلك لم يكن داعيا لتقديم التنازلات أو قبول شروط جائرة من أي من كان، لأن التأسيس للدول يستلزم الأخذ بأسباب القوة والعمل على إدراك ذلك بشتى الوسائل، وتجنُّب كل ما يحول دونها أو يؤخرها أو ينحرف بالدولة عن مسارها لامتلاك أسباب منعتها.

لم يكن الرسول في انهماكه الشديد ببناء الدولة داخليا واختيار أفضل العناصر ممن حازوا السبق من أصحاب الكفاءة المشهود لهم – ليغفل عما يراد بدولته الناشئة من كيد الكائدين، فما كانت العرب –وعلى رأسهم قريش– لتسمح لهذه الدولة أن تقوى دون مناوئة شديدة على طريق المواجهة المسلحة التي أصبحت أمرا حتميا مهما طال إرجاؤه، وكان الأساس المتين الذي انطلقت منه الأمة حاملةً رسالتها للعالم هو: أنَّ أمر الإسلام أمر عزةٍ ومَنَعَةٍ لا ذلة وصغار، أمر قوةٍ قوامها العدل والرحمة والرفق، لا الغشم والظلم والطغيان، أمر هدايةٍ وتبصرةٍ لا تعميةٍ وضلال، أمر محاججةٍ بالتي هي أحسن لا إرغامٍ وقهرٍ أو عسفٍ وفرضٍ للرأي.. من هنا كان انبعاث النور العلوي الذي غمر الدنيا كشلال ضياء ينهمر من عليائه دون استعلاء ولا غطرسة دحضا لقول من ادعى “أن على المؤمن أن يكون مستعليا بإيمانه على من سواه” وهذا معنى شديد الغرابة ولا أصل له، فعزة الدين في تفرده بنبل الغاية وعظمة المقصد ويسر الوسيلة، ولعل هذا ما يوضح كيف أصبح البون شاسعا بين الإسلام الذي عرفه الأوائل على يد معلم الأمة وهاديها، وهذا الذي ادعوه؛ فصار علما على القتل والدمار والإرهاب واستباحة الحرمات!
إنَّ المؤمن يدرك معنى العزة بالاستغناء بالله عمن سواه، فالأقرب إلى القبول في تأويل قوله تعالى: “فلله العزة جميعا” أن هذا المبتغى غير مدرك إلا عنده سبحانه، فمن أراد العزة فليتعزز بالله، أما من ابتغاها –من هذه الأمة– عند غير الله ذلَّ وهان وصَغُر في أعين الناس، وصار محتقرا لديهم، وتصير حاله من سيئٍ إلى أسوأ فـ “مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ”.
ولقد كان المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه منذ البداية يؤكد على أن أمر الإسلام إنما هو أمر عزّة لا مكان فيه لقبول الدَّنيَّة والصغار، والصبر في حال الاستضعاف لا يصدر عن خنوع واستسلام بل عن يقين بالنصر مهما طال العسر، فـ “… واللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هذا الأمْرَ، حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لا يَخَافُ إلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ علَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ”.
“لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الإِسْلامَ وَذُلا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ”

وكان الرسول في يوم الحديبية يرى الأمر فتحا ونصرا، وإن رأى كثير من المسلمين غير ذلك؛ لأن الهدف الذي سعى إليه؛ كان اعتراف قريش بدولة المدينة ونديتها لمكة، كذلك استثمار الهدنة في نشر دين الله بين القبائل العربية ليزداد الإسلام قوة وعزة ومنعة، وقد كان له ما أراد؛ حتى أنَّ المصادر أكدت أن المسلمين تضاعفوا أضعافا خلال عامين؛ فقط قبل أن تنقض قريش عهدها.. فقد توجَّه الرسول لمكة معتمرا في ألف وأربعمئة رجل لا يحملون إلا السيوف في أغمادها، وكان ذلك غرة ذي القعدة في العام السادس للهجرة، وكان دخوله مكة بعد ذلك في رمضان عام ثمانية هجرية في أكثر من عشرة آلاف مقاتل كاملي العدة والعتاد، وكان الرسول قد أرغم قريشا على التماس إلغاء أشد شروط الصلح إجحافا وهو التزامه برد من يأتيه من قريش مسلما بعد ما كان من أمر أبي بصير ومن معه من قطع طريق عير قريش والإغارة على تجارتها، وتجدر الإشارة إلى إصرار الرسول على استثناء النساء من هذا الشرط.
لقد كان منطق العزة الإسلامية حاكما فيما يصدر عن العصبة المسلمة من أفعال حتى أن عروة بن مسعود الثقفي الذي أرسلته قريش مفاوضا عنها، وكان من أحكم العرب وأعزهم حتى قيل أنه المقصود بقولهم “… رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ” يقول لقريش بعد ما رأى من أمر المسلمين “يا قوم، إني قد وفدت على الملوك، على كسرى وهرقل والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمدٍ في أصحابه؛ والله ما يشدون إليه النظر، وما يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمرٍ فيُفعل، وما يتنخم وما يبصق إلا وقعت في يدي رجلٍ منهم يمسح بها جلده، وما يتوضأ إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيءٍ؛ وقد حرزت القوم، واعلموا أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم؛ وقد رأيت قوما ما يبالون ما يصنع بهم إذا منعوا صاحبهم؛ والله لقد رأيت نسياتٍ معه إن كن ليسلمنه أبدا على حال؛ فروا رأيكم، وإياكم وإضجاع الرأي، وقد عرض عليكم خطةً فمادوه! يا قوم، اقبلوا ما عرض فإني لكم ناصح، مع أني أخاف ألا تُنْصَرُوا عليه! رجلٌ أتى هذا البيت معظما له، معه الهدي ينحره وينصرف”.
ونرى عزة الإسلام منهجا واضحا لا يمكن غض الطرف عنه في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكذلك في اختياره لحاملي رسائله التي تضمنت عبارات حاسمة كما يقتضيه الأمر..” أسلم تسلم” وكذلك “فإن أبيت فعليك إثم…” و لا عجب أن تصل هذه الرسائل إلى بلاط أقوى ملوك الأرض، وأن تلقى من معظمهم القبول برغم أن دولة الإسلام آنذاك لم تكن لتضم أكثر من ثلاثة آلاف نسمة، ولا تمتد خارج مدينة رسول الله إلا قليلا.. لكنها روح العزة التي تعلن عن نفسها في كل لحظة ترسيخا لمعانيه في النفوس، وبعثا للرجاء في أفئدة تلمست النور؛ فضحّت من أجله بالغالي والنفيس، وإيعازا لأصحاب البطش بأن القوة الحقيقية تكمن في القدرة المطلقة على التضحية والفداء من أجل المبدأ والغاية النبيلة.

ويرى المؤرخ الأمريكي “ميتشل هارت” أن الرسول محمد هو الوحيد الذي نجح نجاحا لا نظير له على المستوى الديني والدنيوي، بالرغم من نشأته في محيط بسيط، بعيدا عن الفنون والعلوم، إلا أنه استطاع في زمن قصير أن يستقطب جميع القبائل في جزيرة العرب، ويجعلها بحكمته وسياسته تدخل في الإسلام عن قناعة وايمان مستعينا بالقرآن الكريم”.
وبالنظر في جميع المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها الرسول الأعظم نجد أن السياسة الخارجية للدولة الإسلامية تنوعت تنوعا كبيرا، وإن كان أساسها هو تقدير الضرورات ما بين تحييد بعض القوى، واستمالة كيانات أخرى والتعاون القائم على حسن الجوار مع قوى رأى النبي أنها من الممكن أن تقوم بأدوار تخدم الدولة الإسلامية فيما بعد، كما كان في حلفه مع خزاعة.
وفي عام الوفود تتجلى صورة إسلام العزة في كثير من المواقف، فكانت المدينة تتهيأ لاستقبال تلك الوفود، وكان الرسول يحرص على استقبالهم بنفسه ويرحب بهم”.. ويوسع لرؤسائهم في المجالس، ويجلس إليهم، ويؤنسهم في الحديث، ويتلقاهم بالبشر وطلاقة الوجه، ويكلمهم باللين والرفق واللطف، ويسألهم عن أهاليهم وبلادهم، ويدعو لهم، ويغير الأسماء غير الجميلة منهم إلى أسماء حسنة، ويحلم عن جاهلهم، ويعفو عن مسيئهم”.
كما كان يستجيب لمطالبهم ما وسعه ذلك، ويجزل لهم العطاء، حتى قال عنه أحدهم لقومه عندما عاد إليهم “جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر” وكان إغداقه على العرب أظهر لعزة الإسلام من غيره، لاعتبار العرب الجود رأس الفضائل، وعندما أرادوا أن يصفوه بعد ذلك قالوا عنه “كان أجود بالخير من الريح المرسلة”.. وهو القائل “ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار..” فهكذا يكون القائد غزيزا أبيا كريما معطاء لا يسبقه أحد في سعيه نحو الفضائل.

فما أحوجنا للاقتداء بالحبيب في عصرنا هذا! وما أحوجنا إلى تمثل صفاته وأخلاقه! وما أحوجنا لتلك العزة التي كانت المحرك والأساس لكل ما يتعلق بالدولة الوليدة، حتى بلغت بقيادته أن جمعت المجد من أطرافه؛ ما أحوجنا لعزته وعلو همته؛ لنؤكد لكل ذي غرض أن الذلة والصغار والتهاون ومداهنة الأعداء لا يمكن أن تكون سبيلا للخير ولا طريقا لنيل الحقوق، ولو كثر السالكون.
إننا في ذكرى المصطفى-صلى الله عليه وسلم- مطالبون أن نحتذي خلقه، وأن نثنْعِمَ النظر في سيرته، واختياراته وانحيازاته، ونلتمس فيها طريقا للخروج من الهاوية التي صرنا إليها، ونحن اليوم في أشد الحاجة لتمثل منهجه في العزة والمنعة التي اختارها لأمته، وجعلها أساسا لدولته.. فما أصدق القائل “نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله” ولن تعرف تلك العزة الطريق إلى نفوسنا إلا إذا كنا صادقين في اللجوء إلى الله بالاقتداء برسوله الذي لا ينقطع فيه رجاؤنا، حتى مع اعترافنا أننا صرنا عن هديه أبعد؛ لكن رجاءنا فيه لا يخرج عن قوله سبحانه “لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (128)التوبة.. فاللهم صلنا بمحبته مقتدين، ولا تجعلنا لنهجه مبدلين، اللهم وألهمنا العزة نحسها في الأرواح نفرة إباءٍ وانتفاضة رفضٍ لكل ما يروج من خضوع ونخاسة تحت مسميات عديدة ما أنزل الله بها من سلطان.









