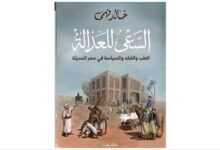انتهى عهد أبي بكر الصديق –رضي الله عنه– والقرآن مجموع في صدور الرجال ومجموع في صحائف/ رقوق متشابهة في الطول والعرض، متفقة في النوع ومرتبة بين دفتين –ستُعرف بالمصحف– ولم يكن هذا المصحف مرجعا للقراءة والتعلّم، بل هو أصلٌ رسمي لما حفظ الحفّاظ، يُمكن الرجوع إليه متى اشتبه أو التبس على حافظ من حفّاظ القرآن كلمة، بما يَقِي النّص الديني من أن ينقص أو يزيد منه شيء، وقد احتفظ المصحف الأول باللهجات المختلفة بين العرب تيسيرا عليهم وتسهيلا، وهي ما يُظنّ أنّه الأحرف السبعة في الخبر الذي يرويه أُبَيُّ بن كعب “إنَّ القُرآن أُنزِل على سبعة أحْرُفٍ؛ فاقْرَءُوا ما تيسر مِنه”.([1])
لقراءة الأجزاء السابقة:
رحلة المصحف.. من الذاكرة والتدوين إلى الطباعة (1)
رحلة المصحف من الذاكرة والتدوين إلى الطباعة (٢)
وكما كان الجمع في عهد أبي بكر –رضي الله عنه– وليد تطور اجتماعي وبدافع من الخوف على النّص المقدّس، كان الجمع في عهد عثمان –رضي الله عنه– ناتجا عن تطور اجتماعي جديد، فبعد أن كان كلّ مجتمع عربي يقرأ القرآن بحرفه/لهجته في قومه ومنطقته، ولا يلتقى أفراده بغيرهم من أصحاب اللهجات الأخرى إلا لسبب طارئ ولوقت قصير؛ تغيّر الواقع الاجتماعي بسبب توسّعات المسلمين على حساب مملكتي الروم والفرس، فالتقت القبائل على اختلاف لهجاتها في المعارك وفي المدن الجديدة التي أخذوا يستقرون بها، وكان لهذا أثر إيجابي في الإسراع بتوحيد اللهجات العربية، وتراجع ما بينها من اختلافات إلا أنّه في الوقت نفسه كان له أثر سلبي، فقد ثار جدل حول أي طرائق نطق القرآن الكريم المتعددة هي الأصوب، جدلٌ أدى إلى خلافات في مجتمع عربي شديد التعصّب، سريع الغضب، فتُحدّثنا كتب التاريخ: أن خلافا حول قراءة القرآن قد وقع أيام الخليفة الثالث بين أصحاب الأحرف العربية/اللهجات العربية في معسكرات المسلمين في أرمينية، وتحديدا بين أهل الشرق من العراقيين، وأهل الشمال من الشاميين، بعد أن تشاجروا فيما بينهم بسبب اللهجات التي كان يُقرأ بها القرآن، والتي لم تكن معروفة لأهل الأمصار جميعا في ذلك الوقت، ولم يكن من السهل أن تُعرف بينهم؛ لأن كلّ صحابي في إقليم إنما كان يُقرئ أتباعه بما يعرفه فقط، وكان طبيعيا أن يأخذَ كلّ إقليم بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فأهل الكوفة –على سبيل المثال– كانوا يقرءون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل الشام كانوا يقرءون بقراءة أُبَيّ بن كعب. وكان بين القراءتين بعض الاختلافات الصوتية ناشئة عن أنّ كلّا منهما قد تلّقى بعض كلمات القرآن عن النبي بلهجته الخاصة، وقد أفْزع خلافُ الجنود حذيفة بن اليمان؛ فقدِم على عثمان مستجيرا به أن يتدارك هذا الاختلاف([2])، وفي الوقت نفسه كان قد اتّسع أمر الخلاف حول لهجات قراءة القرآن؛ ليصل إلى معلمي القرآن الكريم في الحجاز الذين اختلفوا فيما بينهم، وكفّر بعضهم بعضا، على حدّ تعبير ابن جرير الطبري([3]) واختلف كذلك تلاميذُهم الذين تدارسوا القرآن على أيديهم، حتى اقتتل الغلمان والمعلمون بالمدينة، فبلغ ذلك عثمان فجمعهم، وقال لهم: “عندي تُكذّبون به وتلحنون فيه! فمن نأى عني كان أشدّ تكذيبا وأكثر لحنا. يا أصحاب محمد، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما (أي مصحفا إماما) يجتمعون حوله ولا يختلفون”.
هنا أدرك عثمان –رضي الله عنه– حاجة المجتمع إلى تهيئة الأصل الرسمي الذي جُمع في عهد أبي بكر–رضي الله عنه– للتداول المعرفي بين المدن الجديدة، لتتغيّر بذلك سِمة المخطوط الأول للمصحف الذي أخذ طابعا فرديا أو شخصيا ببقائه محفوظا عند الخليفتين أبي بكر ثم عمر –رضي الله عنهما– ليصبح وثيقة عامة للبشر كافّة بعد نشره في عهد عثمان –رضي الله عنه– بعد معارك أرمينية وأذربيجان.([4])
وبذلك تحققت نبوءة عمر بن الخطاب الذي استشرف منذ أكثر من عشرة أعوام أن المسلمين سيكونون في حاجة إلى مرجعية نص مكتوب للقرآن الكريم كاملا، وعدم الاكتفاء بذاكرة الحفّاظ فحسب.. وكان الجمع العثماني للقرآن ليس جمعا لأجزائه، فقد قام بهذا من سبقه، وإنّما جمع لقلوب المسلمين حتى لا يختلفون حوله، وينقسمون انقسام أتباع بعض الديانات الأخرى على كتبهم.
وقد وصف الشيخ محمود شلتوت والشيخ أمين الخولي تطوّر صورة المصحف في عهد الخليفة الثالث بأنه إدراك “ماذا تُريد الحياة من المسلمين أن يفعلوا بالنص المحفوظ مرجعا؟ إنّهم في حاجة إلى أن يُقدموا منه أصولا للقراءة، يُرجع إليها، ويأخذ عنها المسلمون على اختلافهم.. من أصحاب لهجات عربية كانت لهم أمسُ استطاعةٌ للقراءة بها تيسيرا عليهم، وقد غدوا، بعد جيل تغيّرت فيه الحياةُ تغيّرا جوهريا كبيرا، لا ضرورة تقضي عليهم باستعمال حروفهم (لهجاتهم)؛ لئلا يختلفوا، فقد صاروا بحيث يستطيعون الاتفاق.. وإلى تلك الأصول من المصاحف يرجع المسلمون من غير العرب وعنهم يأخذون، وما بهؤلاء حاجة إلى شيء من خلاف؛ لأنهم يأخذون العربية أخذا كسبيا جديدا، فلتكن بحرف (لهجة) دون سواه، فكلّه لديهم سواء، وكذلك كان عمل عثمان: هو تقديم هذه المصاحف الأصول؛ لتكون مرجعا لقراءة القرآن ينتهي إليه كل عربي مهما تكن لهجته، وينتهي إليه كلّ مَنْ عدا العربي من المسلمين”. ([5])

تدارس عثمان –رضي الله عنه– مع علماء الصحابة المقيمين في المدينة أسباب الأزمة/الفتنة ووسائل علاجها، وانتهوا إلى ضرورة عمل نُسخ من القرآن تُرسل إلى المدن، وتكون أصلًا للقراءة والكتابة يُرجع إليها كلّما دعتْ الحاجة، ويُعتمد عليها، ويأخذ عنها العرب جميعا على اختلاف لهجاتهم كما يأخذ عنها غير العرب من المسلمين، ولا يخفى أنّ قرار عثمان له صفة علمية بوصفه صاحب رأي واجتهاد وصفة سياسية بوصفه الحاكم العام/الخليفة، وكما تُؤكد الروايات أنّ جمع الناس على مصحف واحد لم يتم في الخفاء وإنما كان على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمشاورة من أهل القرآن بما ينفى أي مؤامرة على القرآن.([6])
فـ”ليس من شك في أن ما أقدم عليه عثمان من توحيد المصحف وحسم هذا الاختلاف، وحمل المسلمين على حرف واحد، أو لغة واحدة يقرءون بها القرآن، عمل فيه كثير من الجراءة، ولكن فيه من النصح للمسلمين أكثر مما فيه من الجراءة. فلو ترك عثمان الناس يقرءون القرآن قراءات مختلفة بلغات متباينة في ألفاظها، لكان هذا مصدر فرقة لا شك فيها، ولكان من المحقق أن هذه الفرقة حول الألفاظ ستؤدي إلى فرقة شر منها حول المعاني بعد أن كان الفتح، وبعد أن استعرب الأعاجم، وبعد أن أخذ الأعراب يقرءون القرآن”. ([7])
وتشكّلتْ لجنة لكتابة القرآن على حرف واحد (لهجة واحدة) من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن،([8]) وتكوّنت من زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر–رضي الله عنهما– يطلب الصحفَ التي كُتبت في عهد أبي بكر فأتوا بها، فأعادوا كتابتها في أصل جديد، فمهمة هذه اللجنة هي أن تعمل على إخراج نُسخ نصيّةٍ مكتوبةٍ للقرآن الكريم من الأصل المحفوظ عند السيدة حفصة أمّ المؤمنين، وهنا تتباين الأفهام والآراء بين قائل: بأنّ تلك النسخ كُتبت بلغة/ لهجة قريش وحدها، وأُخرج ما عداها من اللهجات/ الأحرف، وبين قائل: بأنّه قد خُصّت كل نسخة بحرف/لهجة بعينها، وأميل إلى الرأي الثالث الذي يرى أنّ مهمة لجنة زيد بن ثابت هي إخراجٌ كتابيّ للنّص القرآني يُمثل في رسمه/حروفه المكتوبة اللهجات التي أنزل بها القرآن، والذي تُركت إباحة القراءة بها إلى حين، وخير دليل على ذلك وصية الخليفة الثالث قائلا: “إذا اختلفتم وزيدا بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش”. ([9]) وخصّ زيدا؛ لأنّه خزرجي وليس قرشيا، وقريش هي التي اتّجهت الأحداث الاجتماعية إلى تغليب لهجتها/ حرفها، فاللجنة حريصة على أن يتحمل الرسم/خط المصحف أوجهَ الأحرف السبعة، فإن تعسر ذلك كان الحسم للهجة قريش.
وتختلف المصادر حول عدد المصاحف التي كُتبت، فيُروى عن أنس بن مالك –بلا تحديد– قوله: “وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا”.([10]) وقيل أربعة، ويروى أبو داود عن أبي حاتم السجستاني: أنها سبعة مصاحف،([11]) والمشهور أنّها خمسة أو ستة،([12]) وُجهت كلّ نسخة منها إلى ولاية/ مدينة كبرى، فبعد أن أبقى الخليفة نسخة، وقيل اثنتين منها بالمدينة عاصمة الدولة إذ ذاك، بعث بنُسخ من المصاحف إلى مكة ودمشق، والبصرة، والكوفة، وقد أوفد عثمان مع كل مصحف صحابيًّا يُعلّم أهل كلّ مِصْرٍ قراءته، فأمر زيدا بن ثابت أن يُقرئ أهل المدينة، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، وابن عبد الرحمن السني مع المصحف الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع المصحف البصري.
وراعوا في تلك المصاحف أنْ تحفظ ما في المصحف الأول (مصحف أبي بكر) من حرف/لهجة قريش، وما قد يكون لسواها لكن وفقا لما تنطقه قريش، وقد ساعدت صورة الخط العربي في ذلك الوقت على أن يتضمن المصحف رسما محتملا لبعض اللهجات التي قرئ بها القرآن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم
ويرى الشيخ أمين الخولي أنّه رغم صعوبة عمل لجنة زيد بن ثابت، إذ كان عليها أن تُوفّق بين هذه اللهجات ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وكان عليها أيضا أن تجعل لهجة قريش هي ملاذهم الأخير، وهو ما نجحت فيه، فخروج القبائل العربية في صفوف جيوش المسلمين خلافة أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما– منح تلك القبائل فرصة الاندماج السريع مما سهّل على لجنة المصحف تلك المهمة الصعبة، فكان لحركة الجيوش أثرها في ازدياد اختلاط العرب ببعضهم البعض، وازدياد تفاهمهم فيما بينهم في ميدان القتال وفي المسجد، وفي المدينة وفي البيت في شتّى شئون الحياة، الأمر الذي ترتب عليه تضييق مسافة الخلاف بين تلك اللهجات المتنوعة التي كانوا يتحدثون بها، فاقتربت هذه اللهجات من الوحدة اللغوية أو كادت بفضل هذا الامتزاج، ولم يعشْ منها إلا ذلك القدر الذي يحتمل تصويره رسما واحدا عند الكتابة.
وحتى يكون ذلك واضحا؛ نتوقف عند بعض الأمثلة من الآيات القرآنية؛ التي يُمكن على أساس رسمها في المصحف أن تُقرأَ بصور مختلفة حسب اللهجات العربية، ففي الآية التاسعة من سورة المؤمنين التي نصها: “والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون” يمكن أن تقرأ الكلمة الثالثة بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع ولا يختل المعنى، وفي الآية العشرين من سورة سبأ التي نصها: “فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا” يمكن أن نقرأ الكلمة الثانية بالرفع بدلا من النصب، والكلمة الثالثة بصيغة الماضي بدلا من صيغة الأمر “باعد” ولا يختلّ المعنى.
وفي الآية السادسة من سورة الحجرات التي نصّها: “يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” يمكن أن نقرأ فتثبتوا بدلا من “فتبينوا”، ولا يختلّ المعنى. ويمكننا أن نُضيف إلى ما تقدم إمكان استعمال الفتح، أو الإمالة، أو الترقيق، أو التفخيم، أو الإظهار، أو الإدغام دون أن يختلّ المعنى. وهذه القراءات المختلفة التي ضربنا لها تلك الأمثلة لا تحتاج إلى تغيير في الصورة المكتوبة، فعدم تمييز الحروف المتشابهة في الكتابة المختلفة في النطق، يجعل رسم كلمة ” فتبينوا” واحد في القراءتين، وحذف الحركات الممدودة في الكتابة وإثباتها في النطق يجعل كلمة “لأماناتهم” واحدا في حالتي الإفراد والجمع، كما يجعل رسم كلمة “باعد” واحدا في حالتي الأمر والماضي.
وأغلب الظنّ أن اللهجات الناطقة بالقرآن لم تختفِ بقرارات عثمان وتقارب القبائل كما يصور الشيخ الخولي، لكنّها انْزوتْ، وبدأ يدبّ فيها الضعف، وأخذت في التلاشي تدريجيا، فقد أدركها ابن جرير الطبري في القرن الثالث الهجري ووصف القراءة بها بالنّدرة، فيقول: “رأت الأمة أن فيما فعل عثمان الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم إمامها العادل على تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملّتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بـها لندورها، وعفوّ آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بـها من غير جحود منها بصحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل الدنيا، فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداها من الأحرف الستة الباقية”.
وما حدث من تقديم للقرشية على غيرها هو راجع إلى سنن لغوية واجتماعية تعمل على انتخاب لغوي لا بمحض رغبة فرد أو أفراد، أو محاولة سيطرة تفرض ذلك، فاللغة العربية في سيرها التطوري شهدت تفاعلا بين اللهجات العربية القحطانية اليمنية الجنوبية واللهجات العربية العدنانية الشمالية، وانتهى الأمر بها إلى لهجات عدنانية أخذت من آثار القحطانية اليسير، ثم تفاعلت تلك اللهجات العدنانية بعضها مع بعض، من شرق الجزيرة إلى غربها، بعد التفاعل بين شمالها وجنوبها، وفي الغرب حيث الحجاز، بكعبته معبد العرب الأكبر قبل الإسلام، الذي إليه يحجُّ جموعهم، ومنه خرجت الدعوة الجديدة/دعوة الإسلام، كان تفاعل لغوي انتهى إلى لغة قوامها القرشية السائدة في المنطقة قبل الإسلام وبالإسلام، وهذا التفاعل اللغوي هو انتخاب لساني يستبقى الأصلح والأمثل.
وبعد أن أتمّت اللجنة عملها عام ٢٤ أو ٢٥ هـ كما يرجح ابن حجر، “أَمَرَ (عثمان) بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ”. ([13]) فتحقيقُ الهدف الأكبر من هذا العمل وهو الوحدة، يتطلب قرارا ثانيًا، وهو إلغاء الاعتبار الرسمي لكل ما عدا هذه النسخ المأخوذة عن الأصل المحفوظ، فكان أمر الخليفة الثالث بإحراق ما عداها من مصاحف خاصة غير رسمية تحمل لهجاتٍ أخرى، فكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة.
فـ”حسم الفتنة وقطع الخلاف، ولو قد كانت الحضارة تقدمت بالمسلمين شيئاً لكان من الممكن أن يحتفظ عثمان بهذه الصحف التي حرقها على أنها نصوص محفوظة لا تتاح للعامة، بل لا تكاد تتاح للخاصة، وإنما هي صحف تحفظ ضنا بها على الضياع. ولكن المسلمين لم يكونوا قد بلغوا في ذلك العصر من الحضارة ما يتيح لهم تنظيم المكتبات وحفظ المحفوظات، وإذا لم يكن على عثمان جناح فيما فعل لا من جهة الدين ولا من جهة السياسة، فقد يكون لنا أن نأسى لتحريق تلك الصحف؛ لأنه إن لم يكن قد أضاع على المسلمين شيئاً من دينهم، فقد أضاع على العلماء والباحثين كثيراً من العلم بلغات العرب ولهجاتها، على أن الأمر أعظم خطرا وأرفع شأنا من علم العلماء، وبحث الباحثين عن اللغات واللهجات”. ([14])
وتتباين الروايات حول مدى قبول الصحابة لإحراق مصاحفهم الخاصة، فيُروى عن مصعب بن سعد قوله: “لم ينكر ذلك من الصحابة أحد”. ويحكى السيوطي أن إنكارا حدث من بعض الصحابة لا سيما ابن مسعود الذين اعترض على قرار عثمان، وأن هناك من سمّوه بحرّاق المصاحف”. وأرى أن الأمر لا يعدو عن كونه اختلاف مشروع بين جانب كبير من الصحابة انحازوا إلى قرار عثمان ومن بينهم على بن أبي طالب وزيد بن ثابت بما لهما من مرجعية علمية، وبعض الصحابة الذين لم ينكروا المصحف الإمام؛ لأنه نسخة من المصحف المحفوظ عند أبي بكر وعمر، وإنما أنكروا إحراق مصاحفهم الخاصة، أضف إلى ذلك أنّه مع وقوع الاختلاف بين المسلمين في أواخر عهد عثمان، لم تُتهم مساعيه في توحيد الناس حول مصحف واحد وإبطال ما عداه، ورغم أنّ اقتتال الصحابة واختلافهم الذي بدأ قبيل مقتل عثمان رضي الله عنه عام ٣٥هـ باب لكثير من الشرّ إلا أنّه يحمل دلالة أخرى، وهي استحالة أن يقبل هذا المجتمع الذي اقتتل لاختلاف في الرأي/الاجتهاد بأيّ عملٍ من شأنه المساس بكتابه المقدس/القرآن الكريم.
مضت مئات السنين تحوّلت خلالها نسخ مصاحف عثمان –رضي الله عنه– إلى آلاف النسخ من القرآن المحفوظ في الذاكرة والمحفوظ في الرقوق والأوراق، وعلى ما يبدو أن بعض نسخ المصحف العثماني، قد عاشت وسلمت من التّلف حتى القرن الثامن الهجري، فالحافظ ابن كثير (ت٧٧٤ ه) يقول: “أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ٥١٨ ه، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخطٍ حَسَنٍ مبين قوي، بحبر محكم، في رق أظنه من جلود الإبل”. وقريبا من كلام ابن كثير قول أبي عبد الله الزنجاني: “ومصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري في أواسط القرن الثامن الهجري فيقول في وصف مسجد دمشق: “وإلى جانبه الأيسر المصحف العثماني.. المصحف هو الذي كان موجودا في دار الكتب في لينينغراد وانتقل إلى إنكلترا”. وأرجح أنّه لا وجود لمخطوطات مصاحف عثمان –رضي الله عنه– الآن، فإن سلمنا بقدم وعظم القيمة الأثرية للمصاحف الأثرية الموزعة بين العتبات الشيعية المقدسة والمتاحف الأثرية والمكتبات العامة في الشرق والغرب، إلا أنّه لم يُفصل علميا في صحة كونها من مخطوطات القرن الأول الهجري الأول، ففي عام ١٩٧٠ نشر مَجْمَع اللغة العربية العراقي دراسة تُؤكّد أن جميع مخطوطات القرآن الكريم في العتبات المقدسة والمكتبات والمتاحف العراقية لم تخضع للفحص الكيميائي والمكروسكوبي حتى نتأكد من عمرها، كذلك المصاحف المكتوبة بالخط الكوفي بدار الكتب المصرية، فما بها من زخارف ونقوش توحي بأنها رغم قدمها لا علاقة لها بأية نسخة من المصاحف العثمانية.
أخيرا، يُمكننا القول أنّ المصحف الذي بين أيدينا هو المصحف الذي جمع آيات سوره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وجمعه أبو بكر بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم– بشهور قليلة في صحف متساوية عُرفت بالمصحف، وهي نفسها التي قام عثمان –رضي الله عنه– بنسخها عدة نسخ أُطلق عليه “المصحف الإمام” وأن تلك النّسخ بلغت من الشهرة والتداول واستقرّت في الذاكرة استقرار هيئة صلاة النبي في العقل الجمعي للمسلمين، فكما لم يُحك اختلاف بين المسلمين حول الصلاة المفروضة؛ لم يُحك اختلاف بين المسلمين حول آيات القرآن، فرغم اختلاف المسلمين واقتتالهم إلا أنّ قرآنهم مثل صلاتهم واحد لم يختلف باختلافهم.
المراجع:
([1]) رواه البخاري ٢٤١٩، ومسلم١٣٥٧.
([2]) ابن أبي داود، المصاحف، ص١٨ وما بعدها.
([3]) يُنظر: تفسير الطبري ج١، ص ٦٤،٦٣.
([4]) د. محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص٣٨.
([5]) دراسات عن القرآن الكريم، ص٨٥.
([6]) ابن أبي داود، المصاحف، ص ١٢ – المرشد الوجيز، ص٦٤.
([7]) طه حسين، الفتنة الكبرى، ج١، ص١٨٢ وما بعدها.
([8]) ممن قال بأنّ المصحف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي، الإبانة عن معاني القراءات، تحقيق د.عبد الفتاح شلبي، ص٤:٢، ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص١٦.
محمد طاهر الكردي الخطاط، تاريخ المصاحف، ص٤٥،٤٤، شرح النووي على صحيح مسلم ٦/١٠٠، والبرهان للزركشي١/٢٢٦:٢٢٤-٢٤١:٢٣٩، وتفسير الطبري ١/٦٥:٦٣. الشيخ آمين الخولي، دراسات عن القرآن الكريم، ص٧٩،٧٨.
([9]) أخرجه البخاري في باب فضائل القرآن الحديث رقم [٤٩٨٧]
([11]) “سبعة مصاحف أرسلت إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحداً”.. [ابن داود، المصاحف، ص٣٤].