ثمة علاقة قائمة تربط مفھوم الاغتراب الذي یضرب بجذوره في أعماق تراثنا الاجتماعي، بالاستخدامات الحدیثة الشائعة لهذا المفهوم في واقعنا العربي، يتعلق الأمر في المقام الأول بعلاقة الإنسان بمحيطه، ومدى قبوله لنتيجة بيع عمله، وثانيا شعوره بانفصال ذاته بفعل التشيؤ( تحوله لشيء)، ما يعزز من أسباب عدائه لمجتمعه.
أما المنطلق النفسي والاجتماعي في تحديد مفھوم الاغتراب فقد كان يدور في إطار العزلة واللاجدوى، وانعدام المغزى الذي يشكل “نمطا من التجربة يعيش الإنسان فيه ويصبح غريبا حتى عن نفسه”، والمقصود بالاغتراب عن النفس هو افتقاد المغزى الذاتي والجوهري للعمل الذي يؤديه الإنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا، وبديهي أن اختفاء ھذه المزايا من العمل الحديث يخلق شعورا بالاغتراب عن النفس، ويمكننا وصف مفھوم الاغتراب بأنه صراع الإنسان مع أبعاد وجوده.
يجنح الإنسان في أغلب الأحوال إلى الدخول في دائرة مفرغة من المحاولات الرامية إلى إحداث الحد الأدنى من التكيف مع الظروف شبه المستحيلة التي يعيشها، وفي سبيل ذلك يلجأ إلى الإرجاء والإعزاء والأمل والتشبث بالمنظومات القيمية المختلفة، دينية واجتماعية وشعبية؛ لكن ذلك لا ينفع في أحيان كثيرة؛ وتكون النتائج كارثية كما رأينا وسمعنا في الآونة الأخيرة عن الجرائم البشعة التي هزت البلاد، وأعادت الكثيرين إلى التفكير في الأسباب والدوافع إلى أدت إلى حدوث تلك المآسي المروعة.
يشكل القهر عاملا أساسيا في حالة الاغتراب التي يعاني منها الكثيرون على امتداد وطننا العربي الكبير، فالسلطة بأنواعها سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية أو وضعية – تفضل أن يكون الأفراد في حالة من الامتثال التام، وهي حال لا يمكن أن تؤدي إلى نهوض أو تدفع نحو تقدم.. إنها أقرب إلى العجز وأدعى للنكوص وغض للطرف عما يفرضه الواقع من تحديات تجلُّ عن الحصر.
ولا يخفى على ذي عقل أن مردَّ هذا الهوان الذي يتجرعه الإنسان العربي مرغمًا؛ إنَّما هو نتاج يأس، وعدم وعي بالذات، وانعدام قدرة على تلبية الطموح بشكل لا يخصم من كرامة الفرد، ولا يعد حسما من إنسانيته، ولا يجبره على التنازل عن مبادئه أو إهدار قيمه، ومن البديهي أيضا أن يكون هذا الإنسان المهدور الممتثل المُدجَّن هو المواطن المثالي بالنسبة لسلطة تعمل- بلاكلل- على أن يظل منشغلاً بمداراة أحواله المعيشية المادية، بعد أن سلبته كافة حقوقه، حتى بات مخلَّدًا في التهميش والإفقار، مغتربًا عن ذاته ومجتمعه، بل ومحيطه الذي يضيق به يومًا بعد يوم.
يشير الدكتور حليم بركات في كتابه الاغتراب في الثقافة العربية إلى أنَّ مفهوم الاغتراب ما زال غامضًا، فبحسب عالم الاجتماع الأمريكي مالفن سيمن فإنَّ الاغتراب يتحدد في خمسة مفاهيم مختلفة هي: العجز وفقدان المعايير وغياب المعاني والعزلة، وما يمكن تسميته بالاغتراب الذاتي، بينما يرى الباحث الأمريكي أنتوني ديفيدز أنَّ الاغتراب يتألف من خمسة توجهات متشابكة هي: التركيز على الذاتية وعدم الثقة والتشاؤم والقلق والاستياء.
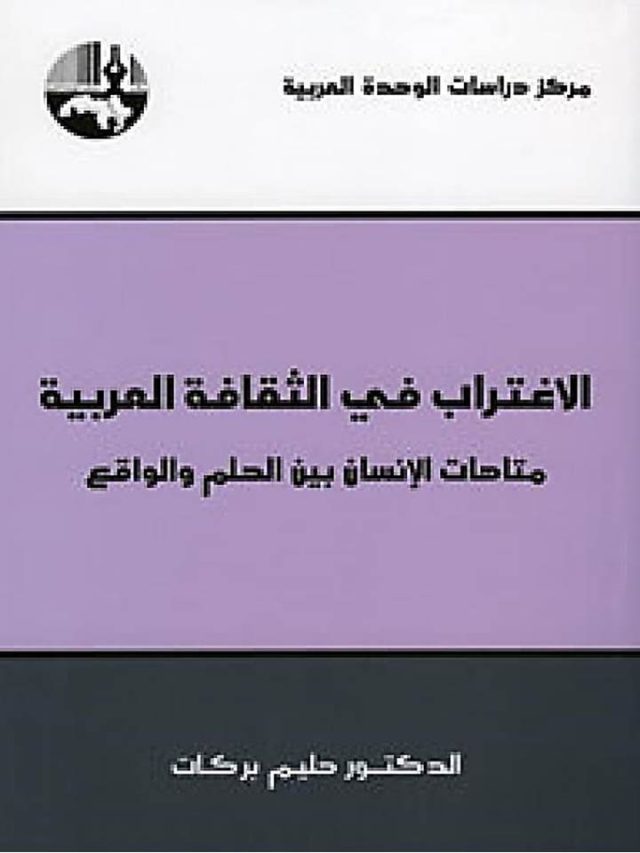
ويرى الدكتور حليم أنَّه ليست ثمَّة عناصر مشتركة بين ما توصَّل إليه العالمان من نتائج، حيث ضاع المصطلح تقريبًا بين مجموعة متفرقة من المعاني، لا تنبئ عن طبيعة واضحة للعلاقات فيما بينها، ومن ثَمَّ فهو يؤكد على أهمية النظر إلى الاغتراب كونه عملية تتكون من ثلاث مراحل أساسية تشمل: مصادره في المجتمع والثقافة، ثُمَّ اختباره كتجربة نفسية وفكرية لدى الإنسان المغترب على صعيد الوعي، وأخيرًا نتائجه السلوكية البديلة في الحياة اليومية من انسحاب أو خضوع أو مشاركة في حركات اجتماعية وسياسية تعمل على تغيير الواقع.
وبحسب هيجل فإنَّ الاغتراب هو نزعة فردانية تنشأ بسبب فقدان الوحدة التي لا يمكن استعادتها إلا بإجراء تحليل منتظم وموسَّع في طبيعة التناقضات الحادثة في المجتمع، بين ما هو خاصٌ وما هو عامٌ أو كليٌ، ويصل هيجل أيضًا إلى أنَّ الاغتراب حالة من العجز واللاقدرة يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظَّف لصالح غيره بدلا منه.
ولا شك أنَّ هذا التنوع في تناول مفهوم الاغتراب على ثرائه يثير قدرًا من الحيرة، حينما نصبح بصدد مواجهته كعائق شديد البأس في طريق استلهام السبيل للخروج من تأزُّمات المجتمع العربي، وتدهوره بفعل التحولات المتسارعة التي باتت تهدد بنيته بالتفتت والانهيار.
لذلك كانت الخطوة الأولى والأهم في سبيل الحفاظ على بقاء الوطن وتماسكه – هي مواجهة الاغتراب الذي أحال الإنسان العربي إلى كائن تتنازعه أسباب الفناء، والسلطة التي لا تعي مخاطر الاغتراب في مجتمعها هي سلطةٌ ذاهلةٌ عن متطلبات الواقع، فالقوة الحقيقية تكمن في تماسك المجتمع ووحدته وتوفير السبل العادلة والكريمة لأفراده، كي يرتقوا في سلمه الاجتماعي، متسلحين بما يجعلهم قادرين على تجاوز الإحباطات اليومية، وعوامل الإخفاق التي تتبدى في انعدام تكافؤ الفرص والمحسوبية وانتشار الوساطة، وتركز السلطة والثروة في أيدي ثلة قليلة من أفراد هذا المجتمع.

فليس من دواعي القوة أيضًا أن نرى مؤسسات الدولة وقد باتت تتصرف وكأنَّ المواطن قد خُلق لخدمتها، يمتثل لإرادتها طوعًا أو قسرًا؛ قابعًا تحت سطوتها في ذلة وخنوع؛ لأنَّ المجتمع ذاته يصبح في تلك الحالة عاجزًا، فاقدًا للسيطرة على وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية؛ خاضعًا خضوعا تاما للدولة التي لا تكون بدورها في معزل عن الخضوع للقوى الخارجية، لذلك يمكننا القول بحسم أنَّ الدولة القوية بحق هي دولة القانون التي تكون خادمة للشعب راعية لمصالحة، حامية لحقوقه وحرياته، وليست هي الدولة التي ترى نفسها سيفًا مسلطًا على رقاب الناس، ولا همّ لها إلا أن يُجبى إليها ثمرات كل شيء.
ويرى الدكتور حليم بركات أنَّ السبيل الوحيد لمواجهة الاغتراب لا يكون إلا بالعمل على أن تنال المؤسسات الثقافية الرسمية وشبه الرسمية الاستقلالية الضرورية للتعبير عن نفسها بحرية، وتجديد القيم التي يجب أن يُنَشَّأ عليها المواطن العربي منذ الصغر، كحرية الإرادة وحق الاختيار والتمسك بالمسئولية التاريخية، والإبداع والابتكار والتفرد والتجدد والريادة والانفتاح على الآخر والتسامح ورحابة الصدر وحق الاختلاف؛ ولن يتأتى ذلك إلا بإحداث تغيير جذري في التعليم والبحث العلمي، كما أنَّ على المثقف العربي أنَّ يجد السبيل لكسر عزلته عن الشعب، والتحرر من تلك الفرضية التي تقول أنَّ الشعب لا يعرف صالحه؛ إذ أنَّ الثقافة بغير ذلك تكون بحثًا في المجردات، وانفصالاً واضحًا عن مهمات التغيير المنوطة بها.
إنَّ حيوية المجتمع وامتلاكه القدرة على التقدم لا يتأتيان إلا من خلال حرية الفرد ووعيه المنفتح على العالم، والمجتمع المعافى هو المجتمع الذي تتمتع الغالبية العظمى من أفراده بفرص عادلة للمشاركة في إدارة شئونه؛ لذلك كان من اللازم أن تتقدم منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها، في إيجاد حالة عامة من الوعي بمشكلات الوطن وقضاياه الكبرى، كما أنَّه يتوجب على السلطة –أي سلطة– أن تتخلّى عن إيمانها المطلق بأن المواطن الممتثل المُدجَّن المنصاع الذاهل عما حوله، هو المستحق الوحيد للقب المواطن المثالي!









