يذهب عدد غير قليل من الباحثين الجادين إلى أن الحلاج بعد عودته من رحلته الثالثة للحج عام 290هــ/904م، تحوّل بمشروعه إلى المواجهة مع السلطة العباسية، مستغلا الظروف العامة التي كانت تشهدها الدولة العباسية على امتداد رقعتها الجغرافية.
في هذا الوقت، واجهت الدولة العباسية تحديات عديدة تمثلت في ثورة القرامطة في شرقي الجزيرة العربية والتي اندلعت منذ 278هـ/892م، مع تنامٍ مطرد للوجود الفاطمي في الغرب الإسلامي بدأ منذ 280هـ/894م، وثورة الزنج في جنوب العراق وما تبعها من اضطرابات كبيرة.
كان عدد غير قليل ممن اعتبرهم الحسين ابن منصور الحلاج من خلصائه – قد انفضوا عنه فور ذيوع أنباء تصريحه بعزمه على الوقوف ضد بطش العباسيين وتجبرهم على الناس.. وكان على رأس هؤلاء، أبو بكر الشبلي، وأبو محمد الجريري.. وكانا من أصحاب الجُنّيد.
وكان الجُنّيد الذي تتلمذ على يده الحلاج، قد نقم عليه عندما أراد الأخير أن يسلك بالتصوف سبيل الجهاد لإحقاق الحق، مبتعدا به عن مسلك الجنيد الذي حصره في العلاقة بين المتصوف والخالق فقط.. وقيل أن الجنيد قد أنكر عليه وقال ببطلان قوله في دعوى التصوف، وأنه لم يفهم التصوف على وجه الحقيقة وقيل أنه عدَّه ممن إذا كُلموا بحق يخالف هواهم قالوا “نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر فلا نتفق”، وربما كان هذا كله، مما لم يقم عليه دليل أنه من قول الإمام الجنيد، وإن كان البعض قد ذهب إلى أن الجنيد قد حسد الحلاج، لكثرة من اتبعوه وصدقوا دعوته وعدوا بالآلاف.. والثابت أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قد دافع عن الحلاج، وقال أن شُطحه كانت لعجز لغته عن التعبير عما يجول بنفسه المعذبة من الحب ونشدان الوصل بالذات الإلهية.
وكان الحجاج قد أقام في مكة عاما كاملا في حجته الأولى؛ يصلي ويصوم، ولما رجع البصرة طفق يعظ الناس، وخلع رداء الصوفية بعد أن اختلف مع الجنيد وبحسب تعبير ماسينيون كان الحلاج “يبحث ويبغي أن يجد كل امرئ.. الله في دخيلة نفسه”. وبعد أن ارتحل إلى خراسان وأمضى فيها خمسة أعوام يدعو الناس إلى الزهد، استقر مع أسرته في بغداد، ثم كانت حجته الثانية مع أربعمئة من أتباعه، ثم سفرته الكبيرة الثانية، وصولا إلى الهند وتركستان والصين.
وكان أن دخل بعض أمراء الحكم قد تحت قيادته الروحية، وكتب الحلاج لهم بعض الرسائل في الأخلاق السياسية، ثم كان أن دالت دولة هؤلاء الأمراء بتغلب أعدائهم عليهم، فألقي القبض عليه.. وكانت نفسه قد طاقت للشهادة.
دامت محاكمة الحلاج تسع سنوات قضاها في السجن يعظ السجناء، ويحرر بعض كتاباته، وكان مما أخذ عليه أيضا، نظريته في تقديس الأولياء التي عدوها ضربا من الشرك، وبعض أقواله التي حملوها على محمل التجديف.
بعد إعدام الحلاج سعت السلطة السياسية إلى تشويه سيرته، وإلحاق كل نقيصة به واستقطبوا لذلك عددا من الأسماء المعروفة في زمنه على رأسهم الإمام الذهبي الذي قال فيه: “فتدبر – يا عبد الله- نِحْلَة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة ودعاة الزندقة، وأنصف وتورّع…؛ فإن تَبَرْهَنَ لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدوّ للإسلام، محبّ للرئاسة حريص على الظهور بباطل وبحق، فتبرأ من نِحْلَته؛ وإن تبرهن لك -والعياذ بالله- أنه كان… محقًّا هاديا مهديا، فجدد إسلامك واستغث بربك أن يوفقك للحق…؛ وإن شككت ولم تعرف حقيقته وتبرأت مما رُمي به أرحت نفسك، ولم يسألك الله عنه أصلا”.
وقد خالف الذهبي منهجه في الحلاج إذ كان قد وضع قاعدة ذهبيّة في حال المختلَف فيهم؛ حيث قال: “إن مَن كان طائفة مِن الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تُثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه؛ فهو ممن ينبغي أن يُعرَض عنه، وأن يفوَّض أمرُه إلى الله، وأن يستغفَر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقين وضلاله مشكوك فيه؛ فبهذا تستريح ويصفو قلبك من الغلّ للمؤمنين”.
وقال إبراهيم الحلواني: “خدمت الحلاج عشر سنين، وكنت من أقرب الناس إليه. ومن كثرة ما سمعت الناس يقعون فيه، ويقولون إنه زنديق توهمت في نفسي، فاختبرته: فقلت له يوما يا شيخ أريد أن أعلم شيئا من مذهب الباطن! فقال: “يا بُني! أذكر لك شيئًا من تحقيقي ظاهر الشريعة: ما تمذهبت بمذهب أحد من الأئمة جملة، وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه وأشده، وأنا الآن على ذلك”. كما نقل أبو القاسم القشيري وهو إمام عمدة لدى أهل التسنن في رسالته ‘القشيرية‘ نصا طويلا للحلاج في توحيد الله.
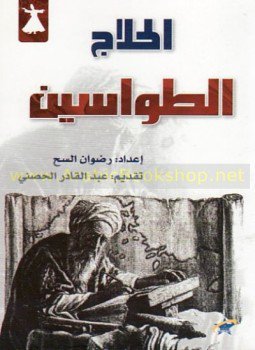
كما أورد ابن زنجي في رسالته “ذكر مقتل الحلاج” شهادة ابن سريج في الحلاج على النحو التالي: قال “الواسطي: قلتُ لابن سريج: ما تقول في الحلاج؟ قال: أما أنا فأراه حافظا للقرآن عالما به، ماهرا في الفقه، عالما بالحديث والأخبار والسنن، صائما الدهر، قائما الليل، يعظ ويبكي، ويتكلم بكلام لا أفهمه؛ فلا أحكم بكفره”.
وأفاد ابن الوردي المعري الكندي في تاريخه بـ”أن أبا العباس بن سريج قال عن الحلاج: “هذا رجل خفي علي حاله وما أقول فيه شيئا”. وفي مجلس محاكمته قال الحلاج: “ظهري حِمَى، ودمي حرام، وما يحل لكم أن تتأولوا علي، واعتقادي الإسلام، ومذهبي السنة، فالله الله في دمي”!
عرض الحلَاج للمحاكمة، بتهمة الزندقة والكفر، حيث جادله الفقهاء والقضاة في آرائه، وكانت له الغلبة وانحاز له جمهور الحضور.. فأوصلوا أمره إلى يد الخليفة المقتدر بالله عن طريق وزيره حامد بن العباس، فوافق الخليفة على إهدار دمه، وصادق على حكم إعدامه، فأعدم بطريقةٍ وحشية، إذ اقتضى التدبير السياسي ألا تكون طريقة الإعدام تقليديّة وإنما فيها من الإرهاب ما يردع غير الحلاج عن سلوك طريقته. فأمر الخليفة أن يُجلد “ألف سوط فإن هلك وإلا ضُربت عنقه”؛ حسب الذهبي. وأُخرج الحلاج تحت حراسة مشددة من الشرطة التي خافت أن تنتشله منها الجماهير؛ حسبما يحكيه التنوخي. وأراد وزير الخليفة، أن يجعل منه عبرةً، لكل المعارضين.

كما لاحق الوزير حامد أتباع الحلاج وأصدقاءه، فمن لم يعد عن مذهب الحلاج دُقَّ عنقه، وقد ذكرت هذه التفاصيل في الكامل لابن أثير، وتاريخ مختصر الدول لابن العبري، والتنبيه والإشراف للمسعودي، والمنتظم لابن الجوزي.
لم يكتف هؤلاء بقتل الرجل، بل امتدت أيديهم إلى سيرة الرجل فأشبعوها تلويثا، وكتب فقهاؤهم في ذلك ما يجل عن الحصر، حتى أنهم ذكروا في معرض ما كتبوا أقوالا شنيعة عنه نسبوها إلى ابن الحلاج وادعوا أنه قائلها، وهو من عُرف ببر أبيه.
وفي مشهد الصلب المهيب.. تعالى بكاء الناس بينما وقف الوزير ورجاله يتشفون في الذبيح.. وقد تقدم من الجسد المصلوب رجلٌ عليه سيماء التصوف.. تعلقت عيناه بالوجه الطيب، وخاطبه قائلا: “يا صاحبي.. ألم أنهك عن العالمين” ثم مضى يكاد يقتله الندم.. فعرفه القوم قائلين: هذا أبو بكر الشبلي صديق الحلاج المقرب وأول من خذله وتخلّى عنه.
رحم الله الحسين ابن المنصور الحلاج وغفر له.. فالثابت أنه كان من أهل الإيمان والتقى والورع والزهد والعبادة والانقطاع، وما كانت دعوته إلا طلبا للحق ودفعا للظلم.. ما استعدى عليه الحسّاد وأعوان الظالمين وأصحاب المصالح من المتأهبين لنيل رضا السلطان وأخذ نصيبهم من فتات موائده.













