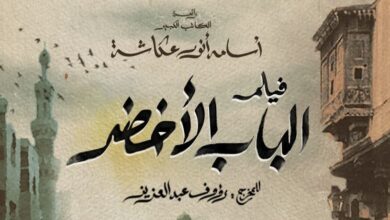على عكس اعتقاد البعض، بأن “الإنسان” طالما ورد مذمومًا في كتاب الله الكريم، في آيات كثيرة، فإن “البشر” يبقى هو المرحلة الأكثر تطورًا، على سلم الخلق.. لكن، مثل هذا القول، بأن الإنسان ورد مذمومًا، لا يكفي ليكون دليلًا على صحة النتيجة التي يراها البعض. وبصرف النظر عن أن مسألة: أيهما أولًا.. الإنسان أم البشر، بخصوص مسألة الخلق؟ قد أُثيرت من قبل، وأنها مسألة قد حسمت، اعتمادًا على اجتهادات مفكرين، مثل المفكر العراقي عالم سبيط النيلي، هو أيضًا قول غير صحيح؛ نعني حسم مسألة النقاش حول البشر والإنسان.
إذ، لما كان القرآن الكريم هو التنزيل الحكيم، فإنه يُصبح المرجعية الوحيدة لحسم أية قضية، عبر تدبر آياته البينات بصورة صحيحة. ومن ثم، طالما أن هناك جديد يمكن أن يُقال في هذه المسألة، لذا لا يتوقف الاجتهاد فيها.
إذن؛ أيهما أولًا.. الإنسان أم البشر، بخصوص مسألة الخلق؟
تسوية البشر
في مقالنا السابق، حول: تشاركية “المادة الأولى” للحياة بين الإنسان والبشر، وصلنا إلى أن التسوية ونفخة الروح لم ترد إلا بخصوص البشر، ولم ترد بالنسبة إلى الإنسان.. وبالتالي، نكون أمام احتمالين: إما أن يكون الإنسان شيء، والبشر شيء آخر؛ وهو، كما يبدو، لغويًا وعقائديًا ودلالة، غير صحيح؛ من حيث إن مكونات كل منهما واحدة “صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ”.. ومن ثم، لا يكون لدينا سوى الاحتمال الآخر؛ أي أن يكون البشر مرحلة والأنسنة مرحلة أخرى.
بل، وأن تكون المرحلة التالية هي أكثر رقيًا من الأولى، عبر التسوية ونفخة الروح؛ بدليل عبارة “فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ” [ص: 73 & الحجر: 30]، التي وردت في السياقين، لتدل على أن البشر بعد التسوية ونفخة الروح، أصبح في مرحلة أخرى، ووضعية أخرى، مختلفة، عما كان عليه هؤلاء البشر من قبل.
وهنا، لنا أن نلاحظ أن اعتراض “إِبْلِيسَ” جاء على البشر الذي خلقه سبحانه “مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ”؛ كما جاء ذكره في قوله سبحانه وتعالى “قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ٭ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ” [الحجر: 32-33]. وهذه الآيات البينات توضح أن الاعتراض “لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ”، إنما يأتي على الصورة الأولى لـ”الخلق”، قبل التسوية وقبل نفخة الروح، أي: “لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ”.
ولأن إبليس، حسب الآية الكريمة، لم يذكر إلا “الِبَشَرٍ”، ولم يذكر “الْإِنْسَانَ” الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، أيضًا، “مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ”، كما في قوله سبحانه: “وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ” [الحجر: 26]؛ لذا، يكون “الِبَشَرٍ” هو الصورة الأولى لـ”الخلق”، ويكون “الْإِنْسَانَ” هو المرحلة التالية، بعد التسوية ونفخة الروح.
ملاحظة أخرى، في السياق نفسه؛ إذ، رغم اعتراض إبليس على السجود لـ”آدم”، الذي أصبح “خَلِيفَةً”، كما في قوله سبحانه: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً…” [البقرة: 30]؛ لم يرد في الآيات البينات أسباب هذا الاعتراض، رغم أنه في الحالين “اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ” [البقرة: 34 & ص: 74]، وكأن سياق الآيات اكتفي فيه بما ورد عن اعتراضه على السجود لـ”الِبَشَرٍ”؛ وهو ما يتبدى في قوله تعالى: “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ” [البقرة: 34].
تكليف الإنسان
يعني هذا، في ما يعنيه، أن الخطاب القرآني، يميز بين الخلق البشري وبين التكليف الإنساني، حيث يرد “البشر” من منظور الوصف للدلالة على الصفات، كما في قوله سبحانه وتعالى: “مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ” [المؤمنون: 33]، حيث يبدو التأكيد على أن الطعام والشراب هما من صفات البشر، وأن الرُسُل الذين أرسلهم الله كانوا من البشر، يأكلون ويشربون كما تأكل بقية الناس وتشرب.
أما الإنسان ـ كمفرد وجماعة ومجموع ـ فيأتي دائمًا كنقطة ارتكاز رئيسة لـ”مناط التكليف”. وهو ما يتبدى بوضوح في قوله سبحانه وتعالى: “وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا” [الأحقاف: 15]، وفي قوله سبحانه: “يَأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ” [الانشقاق: 6]؛ وكذا، في قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ” [آل عمران: 97].
في هذا الإطار، إطار التمييز بين الخلق البشري والتكليف الإنساني، لنا أن نلاحظ آيات الذكر الحكيم التي تفكك الوحدة “الزمانية ـ المكانية” لمراحل الخلق وصولًا إلى “الأنسنة”. يقول سبحانه وتعالى: “هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ” [الأنعام: 2]. وهنا، تنص الآية الكريمة على “الأجل” كعنصر توقيت زماني يمتد ما بين الطين وبين الخلق؛ كما تنص، أيضًا، على “الأجل المسمى” كعنصر توقيت زماني “معلوم عند الله” ما بين “خَلَقَكُمْ” وبين “ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ”.
فإذا، أضفنا إلى ذلك قوله سبحانه: “يَأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ٭ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ٭ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ” [الانفطار: 6-8].. لنا أن نلاحظ، أن هناك إذن، “أَجَلٌ مُسَمًّى”، وفيه تسوية ثم اعتدال؛ والتسوية تنصرف إلى معنى “التكوين”، إلا أن اقترانها بالاعتدال يؤشر إلى مضمون الشكل، أي السابق على الاعتدال؛ وهو ما يؤشر ليس، فقط، إلى أن التسوية والاعتدال، هنا، لهما معان “مادية” وليست اجتماعية؛ ولكن، أيضًا، على أن الآية تتضمن التأكيد على “تعدد الصور” الإنسانية بمؤثرات التكوين الطبيعي الموضوعي. وهذا يختلف قطعًا عن الاستنتاج الدارويني؛ إذ إن “فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ”، تعني التعدد في التركيب تبعًا للمشيئة الإلهية.
خلافة الإنسان
هنا، يتبدى بشكل واضح كيف أن “خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ”، هي مراحل انتقال من حالة “الِبَشَرٍ” إلى حالة “الْإِنْسَانَ” بعد نفخة الروح؛ بدليل افتتاح الآية الكريمة بـ “يَأَيُّهَا الْإِنسَانُ…” [الانفطار: 6]؛ وأن هذه المراحل، هي تأهيل إلهي لهذا “الْإِنْسَانَ” ليكون “خَلِيفَةً”؛ وهو المصطلح الذي ورد، كاصطلاح قرآني، مرتبن في آيات التنزيل الحكيم؛ وفي المرتين ورد المصطلح مصحوبًا بمصطلح آخر هو “جَعَلَ”. في المرة الأولى، ورد المصطلح في قوله سبحانه: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً” [البقرة: 30]؛ وفي المرة الثانية، ورد في قوله تعالى: “يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ” [ص: 26].
وهنا، لنا أن نشير إلى نقطتين أساسيتين، كمداخل، للتعرف على ملامح دائرة الدلالة المتعلقة بلفظ، أو بالأحرى مصطلح “خَلِيفَةً”.
فمن جهة، لنا أن نلاحظ الاختلاف بين الخلق والجعل؛ ففي الخلق يقول سبحانه: “إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ” [ص: 71]، ثم أتبعها بقوله تعالى: “فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٭ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ” [ص: 72-73]؛ وهنا، يبدو أن “الخلق” هو من عالم الغيب كما يقتضي الأمر الإلهي في إبداع الشيء من غير أصل أو احتذاء. وهنا، أيضًا، لم يتساءل الملائكة عن المخلوق، أو عن أفعاله، مع ملاحظة أنهم امتثلوا لأمر الله؛ وذلك على عكس تساؤلهم بالنسبة إلى عملية “جعل آدم خليفة”.
أما في قوله تعالى: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً” [البقرة: 30]، يبدو أن “الجعل” هو تغير في الصيرورة، إذ لم يكن آدم خليفة فأصبح؛ تمامًا كقوله سبحانه لإبراهيم “قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا”[البقرة: 124]، إذ لم يكن إبراهيم، عليه السلام، إمامًا فأصبح إمامًا. وأيضًا، كقوله لداود: “يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ” [ص: 26]؛ إذ لم يكن داود خليفة فأصبح ليحكم بين الناس بالحق. وهو ما يعني أن “الجعل” هو من عالم الشهادة حيث مجرى الصيرورة وتحول الشيء وتصييره على حالة دون أخرى.
من جهة أخرى، لنا أن نلاحظ اختلاف ورود صيغة “جعل”، في ارتباطها بلفظ “خليفة” في الموضعين. فبالنسبة إلى داود فقد وردت في صيغة الفعل الماض، فضلًا عن تصدير الآية بالنداء “يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ”؛ أما بالنسبة إلى آدم فقد وردت في صيغة اسم الفاعل الذي يدل على استمرار العملية؛ عملية “جعل آدم خليفة”، مع عدم ورود اسم “آدم” في الآية. أضف إلى ذلك، أن “الكاف” في “جَعَلْنَاكَ” بالنسبة إلى داود تدل على “الاستخلاف الخاص”؛ في حين أن ورود “جَاعِلٌ” بالنسبة إلى آدم تدل على العموم، خاصة مع ورود لفظ “خَلِيفَةً” في صيغة “النكرة” التي تؤكد هذا العموم.
فالجعل، إذن، لا يعني خلق شيء جديد مستقل بذاته، وإنما هو إحداث تغيير ما في شيء موجود من قبل، أي عملية تحويل شيء من حال سابقة إلى حال جديدة من دون استبدال الشيء ذاته؛ وهو ما يتضح في قوله سبحانه: “فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ” [يونس: 73]، وفي قوله تعالى: “وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ” [القصص: 7].
وفي ما يبدو، هكذا، فإن الخط المستقيم الواصل بين النقطتين السابقتين، يؤشر إلى ارتكاز دائرة الدلالة، في التنزيل الحكيم، على أن “الخليفة”، كمصطلح الذي يأتي مرتبطًا بمصطلح “الجعل”، إنما يؤشر إلى تكليف إلهي لهذا الخليفة.. إذ، بالنسبة إلى داوود عليه السلام، جاء التكليف عبر قوله سبحانه: “فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ” [ص: 26].. أما بالنسبة إلى آدم، فقد كلفه بحمل “التشريع الأول للإنسانية” من خلال “الأسماء” التي تعلمها.
كيف؟