ظل الحديث عن علاقة الإسلام بالحرية السياسية جدليا لقرون طويلة.. كان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين أن الحاكم في الإسلام يتمتع دوما بسلطات مطلقة، وأنه وحده مصدر لجميع السلطات.
وفي كتابه “حرية الفكر في الإسلام” يتساءل الدكتور عبد المتعال الصعيدي، هل الأمة مصدر السلطات في الإسلام؟ ويجيب “الأمة مصدر السلطات؛ فلها حق الاشتراك في تنصيب الحاكم، ولها تعيين شكل ما تراه في الحكم الذي اختارته، ولكل فرد من أفرادها، ذلك كله لأن حقوق الأمة ليست في حقيقتها إلا حقوق أفرادها، وإذا كانت الأمة مصدر السلطات، كان حاكمها تحت سلطانها، ولم تكن هي تحت سلطانه؛ فتكون لها حريتها السياسية بأكمل معانيها؛ لأن الحق في هذه الحرية هو الحق الذي أعطاه الإسلام لها، فهي لم تأخذ منحة من الحكام، ولو أنه كان منحة لم يكن حقا صحيحا؛ لأن من له حق المنحة له أيضا حق استردادها؛ ولهذا أراد الإسلام أن يجعل حق الأمة في حريتها السياسية حقا طبيعيا لها، لا تستمده من حاكم.. إنما تستمده من كونها مصدر السلطات في الحكم، وأنها بصفتها هذه يكون الحاكم تحت سلطتها”.
هكذا يقرر الشيخ المجدد عبد المتعال الصعيدي بعبارات موجزة؛ سلسلة من الحقائق التي تحسم قدرا كبيرا من الجدل الذي أثير حول علاقة الإسلام بالحرية السياسية، والذي أدت مفاهيم مغلوطة، راجت لقرون طويلة من الزمن، وتولدت عنها قناعة راسخة لدى الكثيرين– للقول بأن الحكم المطلق هو الأقرب لمفهوم الفكر الإسلامي.
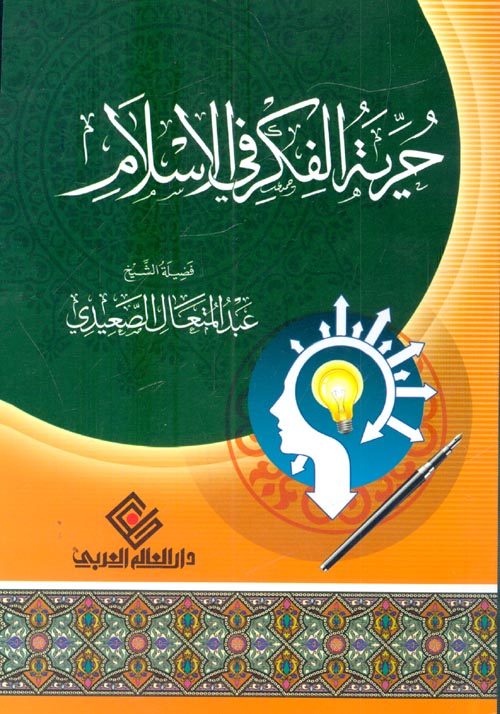
ويستند الدكتور الصعيدي على جملة من الشواهد؛ مدللا على صدق القواعد التي قام بإرسائها.. وفي هذا الصدد يقول: “وعلى أساس أن الأمة مصدر السلطات – قام الحكم الإسلامي في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم– وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده، وهما الحكمان الصحيحان في القرون القديمة للإسلام بخلاف الحكم الذي قام بعدهما من حكم بني أمية وبني العباس إلى حكم الفرس والترك والبربر؛ فإنها لم تكن حكما إسلاميا صحيحا، ولم تكن الأمة فيها مصدر السلطات، وإنما كان الحكم المستبد هو كل شيء في الدولة، وبيده وحده سلطاتها كاملة، ولم يكن للأمة معها حق حريتها السياسية، فأما عهد النبي فقد وصفه لبعض أصحابه بأنه نبوة لا حكم، فلا يمكننا أن نعده حاكما فيه إلا بنوع من التسامح لأنه كان فيه نبيا يتلقى الوحى، ولم يكن مستقلا فيه بالحكم، ومع هذا كان يشرك الأمة في بعض ما لا يكون من أمور هذا الحكم عن طريق الوحي كما استشار الصحابة في غزوة بدر”.
“الأمثلة كثيرة على ما كان يتمتع به المسلمون، في عهد النبوة من الحرية السياسية؛ حيث كان لهم المشاركة في أمورهم التي لا شأن للوحي بها، ولكن هذا الوحي سينقطع بعد عهد النبوة؛ فلابد أن يعطوا شيئا من السلطة في بعض أمورهم، ويترك للوحي ما عداه من الأمور؛ حتى إذا انقضى عهد الوحى كانت السلطات كلها في أيديهم، قياسا على ما أعطاهم من قبل، بحسب ما أكده الدكتور عبد المتعال الصعيدي الذي يضيف “وقد عرف جمهور المسلمين لأنفسهم هذا الحق بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم– بل بادروا باستعماله وبعض أصحابه مشتغل بتكفينه وتجهيزه للدفن؛ حرصا منهم على هذا الحق وخشية أن يسلب منها فتقوم كسروية أو قيصرية فيهم؛ فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لينظروا فيمن يتولى أمر المسلمين منهم.. ولما علم أبو بكر باجتماعهم؛ ذهب إليهم في نفر من المهاجرين، ودار النقاش بين الفريقين في حرية تامة، فيمن يولونه على أمر المسلمين؛ حتى اتفق الطرفان على تولية أبو بكر؛ فتمت توليته باختيارهم له.. وقد اعترف أبو بكر بهذا الحق لهم في أول خطبة عقب توليه الحكم، وأعلن أن حكمه سيكون بتوجيههم فقال: “أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني” وليس أصرح من هذا الاعتراف بأن الأمة مصدر السلطات؛ لأنه اعترف أن توليه الحكم كان بمنحة منها؛ ثم أراد أبو بكر أن يستن للأمة سُنّة أخرى في تولية الحاكم، وهى أن ينوب عنها في تولية من يقوم بعده بأمرها بعد استشارته لها”.

ويكمل الدكتور الصعيدي “تولى عمر بعد أبي بكر على أساس أن الأمة مصدر السلطات أيضا، وسار عمر على هذا الأساس في خلافته عليها، وكان عهده أزهى عهود الخلفاء الراشدين، ولم يحصر عمر من يتولى الحكم بعده في شخص واحد، كما حصره أبو بكر.. وإنما حصره في ستة نفر، ليكون الأمر فيه شورى بينهم وسار عثمان على منهج الشيخين قبله”.
ويقول الصعيدي في كتابه “لما كانت الأمة مصدر السلطات؛ كان لكل فرد من أفرادها حق في هذه السلطة؛ فيؤخذ رأيه في تنصيب الحاكم.. فكان للفرد حق الاعتراض على الحكم في عهد النبوة رغم اتصاله بالوحي؛ حتى أن أحد الأشخاص قال للرسول – صلى الله عليه وسلم- وهو وسط أصحابه معترضا على تقسيمه بعض الغنائم يا رسول الله اتق الله، ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: ” ألا أضرب عنقه؟ فقال له: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: “وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه”. فقال إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم”.









