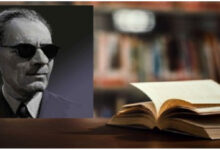منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، وأوروبا الغربية وعلى رأسها بريطانيا، تقود ما يعرف بالثورة الصناعية، التي اتضحت معالمها في القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك بعد تبني نهضة علمية في مختلف فروع العلم؛ أدت إلى اكتشافات علمية مهمة.
وبالرغم من كل الإيجابيات، التي قدمتها الثورات الصناعية المتتالية للعالم، سواء على مستوى زيادة عدد السكان، أو ارتفاع دخل الفرد، أو نمو المدن وتحضّرها إلًّا إنها أيضا تسببت في الإضرار بالغلاف الجوي للأرض؛ نتيجة الاستهلاك المتزايد للفحم، وهو الصورة الصلبة للوقود الأحفوري، بالإضافة إلى صورتيه السائلة والغازية (البترول والغاز الطبيعي).
وبالرغم من تميز الوقود الأحفوري بكثافة طاقته العالية وسهولة نقله وتخزينه؛ إلَّا إنه ينتج عن احتراقه ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والأكاسيد النيتروجينية في الهواء والتي من شأنها أن تمنع الانعكاس الحراري الصادر من الأرض وانتقاله خارجها، ما أدى إلى ظهور ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن ثم زيادة التصحر والجفاف.
إنه نفس القارب الذي يحملنا جميعا؛ بينما يُصر من يُجدِّفون أن يزيدوا من ثقوبه التي سبق وصنعوها فيه بأيديهم، ربما لثقةٍ عمياءَ بقدرتهم على النجاة وحدهم بعد غرق الجميع! وفي المقابل تكون اللامبالاة هي رد فعل منطقي لكل من تُوَّجه إليهم الخطابات، دون أن يسمعهم من يخاطبهم، أو يتيح الفرصة لوجود من يمثلونهم بصدق ويعبرون عنهم.
ولكن العولمة قد فرضت على سكان كوكب الأرض فكرة المواطن العالمي، الذي أصبح يتأثر بما يحدث في العالم، وليس فقط بما ينحصر في حدود بيئته المحدودة والضيقة؛ ولذلك لم يعد هناك أي مجال لحالة اللامبالاة في مواجهة الاستبداد والإفساد العالمي.. وها هي القوى العظمى في العالم ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا – قد أضروا بالغلاف الجوي للأرض لتنضم إليهم بقية الدول الصناعية الكبرى مثل: الهند واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وكذلك تركيا والبرازيل وإيران والسعودية وغيرهم من الدول.
فهل من الممكن باسم حقوق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية على مستوى الكرة الأرضية – أن يتم تدارك ما حدث من تلوث وإفساد لهواء الأرض وثرواتها الطبيعية، سواء المائية أو النباتية أو الحيوانية؟ وهل التحركات الدولية والمؤتمرات الأممية قادرة وحدها على عدم إهدار حقوق الإنسان على هذا الكوكب؟
في عام 1987صدَّقت جميع دول العالم تقريبًا على بروتوكول مونتريال الذي كان بمثابة اتفاق بيئي نموذجي لمواجهة أزمة تغير المناخ والذي حث على ضرورة التوقف عن إنتاج المواد التي تضر بطبقة الأوزون. وفي عام 1992كان التصديق على أول معاهدة عالمية تتعامل مع ظاهرة تغير المناخ بشكل صريح وواضح وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي
UNITED NATIONS FRAMEWORK (UNFCCC)CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
وقد نتج عنها إنشاء مؤتمر الأطراف (COP) Conference of Parties (الذي يضم الهيئة الإدارية العليا للاتفاقية أي الدول الـــ197التي صادقت عليها)، والذي تقرر عقده سنويا للنقاش حول كيفية خفض تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض.
وبالفعل احتضنت ريو دي جنيرو بالبرازبل قمة الأرض أو (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية UNCED) الذي ظهرت فيه المعاهدة البيئية الدولية المسماة ببروتوكول أو “اتفاقية كيوتو”، والتي تمثل خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (والمبدئية) بشأن التغير المناخي؛ ولكن لم يتم اعتمادها إلَّا في عام 1997بعد العديد من المباحثات والمفاوضات الدولية من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي. وأخيرًا في عام 2005 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ؛ ثم بدأ الالتزام بها منذ عام 2008. فلماذا تأخر الالتزام بحماية الأرض من أضرار الاحتباس الحراري طيلة هذه السنوات؟!
لقد توالت قمم المناخ برعاية الأمم المتحدة، وبمناسبة يوم الأرض الذي يُحتفل به عالميًّا في الثاني والعشرين من شهر إبريل تم توقيع اتفاقية باريس للتغير المناخي عام 2016 باعتبارها أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام من بدء الالتزام ببروتوكول كيوتو، وكنتيجة للمفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للتغير المناخي في باريس عام 2015 (COP21). فلماذا تأخر الاتفاق العالمي على احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري طوال تلك السنوات حتى إنه لم يبدأ تنفيذه والالتزام به إلَّا في عام 2020؟ هل بسبب فرض دفع مئة مليار دولار أمريكي كمساعدات من الدول المتقدمة للدول النامية التي تضررت من الاحترار العالمي؟ أم بسبب القيود التي ستضر بإنتاج الدول الكبرى صناعيًّا ومن ثم ستؤثر على نموها الاقتصادي، في حين ستُعفَى منها الدول النامية؟ وأين إذن ما تبديه أنظمة الدول العظمى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم (وبالقوة أحيانًا)، وهي نفسها تفضل إذا لزم الأمر مصالحها الاقتصادية وتبديها على حق كل إنسان على كوكب الأرض في بيئة نظيفة؟
إن اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي العالمي- تعد من أهم الاتفاقيات الدولية إذ طالبت جميع الدول الأطراف بوضع تعهدات صريحة بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، كما نصت على إلزام الدول بالقيام بتقييم التقدم الذي أحرزته فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاقية كل خمس سنوات؛ ولكن للأسف لا توجد آليات ملزمة للدول لضمان تحقيق هذه التعهدات، كما لم تقدم الدول المتقدمة الإسهامات المالية التي نصت عليها الاتفاقية لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الإفساد المناخي العالمي.
ومنذ انعقاد مؤتمر الأطراف الأول في برلين بألمانيا عام 1995م وحتى المؤتمر السادس والعشرين الذي انعقد العام الماضي في مدينة جلاسكو باسكتلندا فإنه ووفقًا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- لم تكن الإرادة السياسية الجماعية كافية للتغلب على بعض التناقضات العميقة، فلا تزال التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بعيدة عما يجب أن تكون عليه من أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش، كما لا يزال الدعم المقدم للبلدان الأكثر ضعفًا والمتضررة من آثار تغير المناخ ضعيفًا للغاية. فهل سيقضى في القمة الحالية المنعقدة في شرم الشيخ على الخلافات بين الدول، حول كيفية تحقيق أي اتفاق بشأن تغير المناخ وفقًا للإطار الزمني المتاح؟
إن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود بعد الصين، كانت هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من اتفاقية باريس. وعلى ما يبدو فإن اعتراض الولايات المتحدة على اتفاقيات المناخ كان يستند إلى رغبتها المحمومة في عدم التنازل عن هيمنتها العالمية وقلقها من أن تنافسها في تلك الزعامة دول أخرى مثل الصين أو روسيا الاتحادية، لذلك سبق واعترض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن على اتفاق كيوتو حفاظا على مصالح رجال الأعمال وقوة أمريكا الرأسمالية. وفي عام 2017، أعلن رجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس التي سبق ووقعها باراك أوباما عام 2016، لأن من شأنها تقويض الاقتصاد الأمريكي؛ ولكن وفقًا للبند الثامن والعشرين من الاتفاق فإنه ليس من الممكن أن تنسحب أية دولة وقعت على تلك المعاهدة إلَّا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق، ثم يبدأ نفاذ أي انسحاب عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الإخطار بالانسحاب من الاتفاق.
فما تخشاه الدول العظمى –وخاصة الولايات المتحدة والصين بصفتهما أكبر الدول الملوثة للمناخ– هو التعرض للمساءلات القضائية بسبب مسئوليتهما التاريخية عن التسبب في الاحتباس الحراري؛ ولذلك حرصا قبل التوقيع على الاتفاقية على إدراج بند يوضح أن ذلك الاتفاق، لن يشكل قاعدة لتحميلهما أية مسئوليات خاصة، قد تؤدي إلى مطالبتهما بأية تعويضات في المستقبل.
وحديثًا مع عودة الولايات المتحدة بوصفها أكبر وأقوى اقتصاد في العالم إلى المشاركة في الاتفاقيات الأممية للمناخ من خلال حضور رئيسها جو بايدن قمة (كوب 27) المنعقدة في شرم الشيخ فقد تم الإعلان عن العمل على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى النصف بحلول عام 2030، وهكذا تكون عودتها محاولة لتحسين صورتها كنموذج يُحتذى به في مكافحة تغير المناخ الذي تساهم بنصيب الأسد في إفساده، وذلك بعدما سبق وانسحبت من اتفاق عالمي يسعى إلى إيجاد حل عالمي لأزمة عالمية تهدد سكان كوكب الأرض.
فهل تلك التعهدات النظرية كافية لاستعادة الولايات المتحدة لمصداقيتها والتزامها بإصلاح بعض ما سبق وشاركت في إفساده؟ وهل ستفي الولايات المتحدة هذه المرة بما قدمته من وعود جديدة بعدما سبق وأخلَّت بوعودها القديمة؛ خاصة وأن أداءها فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتمويل مواجهة التغيرات المناخية يوصف بالتدني الشديد؟ ومن بإمكانه أن يضغط عليها إذا حدث وقصرت في الوفاء بتعهداتها، أو إذا استمرت في انتهاك حقوق الإنسان في مُناخ صحي نظيف وبيئة غير ملوثة؟!