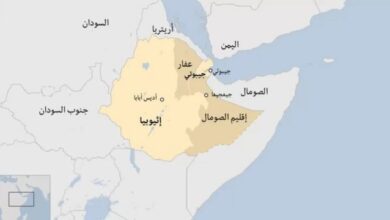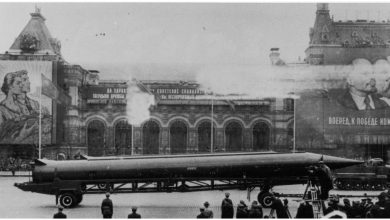لم يكن الرافعي مجرد أديب يمتلك فصاحة الأسلوب وحسن البيان، بل كان عميق الفكر يبحث عن الحكمة ويدرك قيمة العلم والتعلم. فبالرغم من عدم إكماله لتعليمه النظامي الذي كان متعارفًا عليه في عصره والذي لم يزل شائعًا بين الناس إلى الآن؛ إلَّا أن حصوله على الشهادة الابتدائية لم يكن هو نهاية المطاف في تحصيله للعلم، فدأب على القراءة والإطلاع وحرص على توسيع مداركه وآفاق معرفته.
وُلد “مصطفى صادق الرافعي” في بهتيم بمحافظة القليوبية عام 1880 لأسرة ترجع أصولها إلى الشام وسوريا، وكان والده يعمل في القضاء مثل غالبية أفراد عائلته بينما أسرة والدته كانت تعمل بالتجارة، وفي نهاية فترة تعليمه الابتدائي الذي التحق به بعدما حفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية أصيب بمرض تسبب له في ضعف سمعه حتى فقده تمامًا وهو في ريعان شبابه فانكفأ على القراءة والإطلاع بعدما لم يتمكن من مواصلة تعليمه النظامي. وقضى الرافعي بعد ذلك معظم حياته في طنطا حيث كان والده يعمل قاضيًا شرعيًّا فيها، كما إنه بعد موته دُفن فيها وكان ذلك عام 1937.
لقد أثرى الرافعي المكتبة العربية بكتبه الأدبية والفكرية والشعرية والتي كان أولها ديوانه الشعري الذي صدر عام 1903 وهو في ريعان شبابه، ثم كتاب تاريخ آداب العرب عام 1911، هذا بالإضافة إلى كتب أخرى مثل: تحت راية القرآن، وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وحديث القمر، ومن وحي القلم، وأوراق الورد، ورسائل الأحزان، والمساكين. كما اهتم الرافعي بكتابة المقالات التي نشرها في العديد من المجلات الثقافية والأدبية.
وفي عام 1930 نشر الرافعي في مجلة الحديقة مقالًا بعنوان “أمِن عصر العقل إلى عصر القلب؟ – أم مِن عصر العقل إلى عصر المعدة؟”، وطرح في هذا المقال مشكلة الفقر والغِنى بين كلٍّ من العلم والقانون والإيمان، إذ كان يرى الرافعي خطأ من يفكرون في حل مشاكل الإنسانية بالتخلي عن الإيمان (بالغيب) وذلك اكتفاءً بالعلم وبالقانون، بينما بالإيمان سيكون هناك –من وجهة نظره– حل لكل مشكلات الناس.
فمسألة الغِنى والفقر تتعلق بالأساس بالقضاء والقدر، وكل ما يرتبط بهما وينشأ عنه الألم واللذة أو الحزن والفرح لا يمكن أن يعالجه العلم أو القانون بل الإيمان الذي تبعًا له يأمر الشرع وينهى، والذي تُقدِّم فيه العقيدة الإجابة فيما يخص معنى الحياة الإنسانية وغايتها.
ويرى الرافعي أن الإيمان (بالغيب) وهو ما يتعارض مع الإلحاد ليس منه بُد، وذلك طالما هناك قوة أكبر من قوة الإنسان تُسيِّر الكون بأكمله، بل وهو نفسه يخضع لها سواء اعترف بذلك أم لا. وما دام الموت ينتظر البشر جميعًا، وما دامت الحياة الأبدية ليست مِلكًا لبني آدم أو خاضعة لتصرفهم فذلك القصور في القدرة والصفة يفرض على الإنسان الإيمان الغيبي بالقدير والحي الذي لا يموت.
وكما أوضحنا من قبل في مقال سابق كيف ربط الرافعي بين مسألة الغِنى والفقر وبين اللذة والألم، فإن الرافعي يرى أنه لابد من الإنصات إلى فطرة البشر التي تميل إلى الإيمان وليس إلى الإلحاد،كما إنه ليس للعلم أو للقانون القدرة على أن يحلا محل الإيمان الغريزي. ولنتأمل حال البشرية عندما استعلى العلم على الإيمان وأصبح متفردًا في سلطته على الإنسان. لقد تحول الإنسان في عصر العلم والإلحاد إلى مجرد آلة عمياء من آلاته الحديدية الصماء، ولم تبتكر تلك المدنية الملحدة سوى تجميل الأعمال الوحشية لتلك الآلة الإنسانية الحديدية بالكثير من التأنق والتمدن كي تُخفي ما انتُزِع منه من رحمة وشفقة ونُبل، فغدا كل شيء مصطنعًا كي يتناسب مع ذلك الكائن الآلي سواء في سلوكه أو في احتياجاته.
ويوضح الرافعي رؤيته تلك بأنه بالفعل لم يزل معنى تفوق أمة على أمة في ظل التباهي بتلك المدنية الحديثة لا يفيد سوى ابتلاعها ثم هضمها بعد أكلها، وبالقطع فإن تلك القدرة على ابتلاع الأضعف تستدعي المحافظة على النفوذ والهيمنة الشاملة والتسلط الاستبدادي. والفرق الآن أن كل ذلك يتم في إطار أنيق وتحت مظلة إعلام يُجمِّل الصور القبيحة ويُظهِر المحاسن المصطنَعة والمغرِضة بينما يخفي المساوئ والحقائق كي تظل الصورة المعروضة على عامة الناس ناقصة ومزيفة.
فالإنسان الذي كان يتجبر في الأرض قديمًا بقوة بنيانه أو بشراسة سيوفه البتارة أصبح الآن في عصر الآلات المبرمَجة يكتفي بكبسة زر واحدة كي يدمر بلادًا بأكملها دون رحمة أو شفقة، وها هو القانون لم يفلح في معاقبته على شروره وآثامه في حق البشرية بعدما استطاع أن يُسخِّر العلم لخدمة تسلطه وبطشه وطغيانه.
فلماذا لم ينجح القانون أو العلم في الارتقاء بالإنسانية في باطنها مثلما كان التفنن الملحوظ في تجميل ظاهرها؟! ولماذا بات إنسان العصر المتمدين في مهرب من القانون رغم اضطراره إليه، بل وفي معزل عن الأخلاق التي يدعيها؟!
هل يرجع السبب في ذلك إلى ابتعاده عن فطرته السليمة بعدما تحول إلى مجرد آلة عمياء يتم التحكم فيها عن بعد في غفلة منه واستغفال له؟! وكيف له أن يقاوم الآن طغيان المادة وجبروت الآلة بكل تقنياتها العلمية الحديثة وهو جزء من تلك المنظومة العالمية شاء أم أبى؟!
إن الرافعي يرى أن الخلاص للإنسان الذي بات مجرد حبة دائرة في رحى ذلك العالم المضطرب لن يكون إلَّا بالإيمان الذي عليه أن يتمسك به قبل أن يتم دكه فيُخسَف وينهار. ولن يفلح أي إيمان بدون تلك الثمرة التي تدفع الإنسان المؤمن إلى التعاون البنَّاء مع غيره من البشر فيُصلِح في الأرض بعد إصلاحه من نفسه، ويشفق على الضعفاء، ويرحم المساكين، ويعطي بسخاء للفقراء، ويبذل كل ما في وسعه من الخير، ويحمي الآخرين من كل ما يخفيه من شر.
وذلك الوازع الداخلي هو في الحقيقة جزء من فطرته لذلك ليس عليه سوى الاستجابة له لمغالبة نزوعه إلى الشر، ولن يتحقق ذلك إلَّا عن طريق الإيمان الذي يرفض الجهل ويدعو إلى العلم والمعرفة من أجل الإدراك والفهم. وبالتالي فإن العلم والدين معًا هما السبيل كي يتلاءم الإنسان مع الحياة ويغنم منها وفقًا لما يخبرنا به الرافعي. فالعلم وحده سيدفع بالإنسانية إلى ناموس بقاء الأصلح في ظاهرها لإيجاد الأفسد في باطنها، بينما العلم والدين معًا كفيلان بتنظيم الطبيعة ماديًّا وإنسانيًّا كي تسير على ناموس بقاء الأصلح ظاهرًا وباطنًا.
فالعلم الذي يطور حياة البشرية باختراع كل ما هو مبتكر وحديث كي تكون أكثر رفاهية وراحة يُقدِّم من المفاسد للإنسان ما يضاهي ما يقدمه له من مباهج. فمتى نعم الإنسان بالراحة وابتعد عن الكد والعمل اليدوي واكتفى بلمسات خفيفة كي يحرك كل شيء حوله فلن يجد أمامه سوى التفكير فيما يشبع غرائزه وشهواته كي يُفرغ تلك الطاقة المختزنة بداخله. ولذلك يرى الرافعي أن الإنسان عليه أن يوازن بين بيئته التي هو يوجهها وبين طباعه التي هي توجهه أي أن يخضع للحدود الشرعية بحرية ولا يكون إيمانه مُبرِّرًا لتخليه عن العلم.
وعلة الرافعي في ذلك أن طغيان العلم يحفز طبائع البشر للطغيان إذا ضعف الإيمان فإذا ما تزينت الشهوات ولم يكن هناك وازع إيماني أو تقوى فلن يحجم الإنسان عن ارتكاب الآثام والمنكرات والفواحش، ولن يلتفت إلى الحق أو يسعى إلى إقامة العدل؛ إذ أن الشهوات قادرة على تعظيم الأنانية والرغبة في الاستئثار ومن ثم تطويع المغامرة التي تجلب المنازعة والتي بدورها تدفع إلى الحرص الذي ينزع الرحمة فيخفت بريق الروح ليجد الإنسان نفسه في النهاية قد وقع فيه من النقص بمقدار ما زاد له من العلم فتجذبه الجبلة الحيوانية إلى السقوط بنفسه لأسفل سافلين بدلًا من أن يرتقي به سموه الروحي إلى أعلى عليين.
ومن كل ما سبق يتضح في النهاية ما أكده الرافعي من أن فهم مسألة الغنى والفقر لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن ينفصل عن فهم المغزى من الإيمان والغاية من الدين؛ فالإيمان من شأنه ألَّا يهمل الضمير الإنساني، أو ينعزل عن الخُلق القويم، أو يتعارض مع الفضيلة. والإيمان الحق هو المرادف للتقوى التي هي عمل إرادي غايته إيجاد الغرائز العليا في الإنسان كي يصلح بها عمله ويحسن سعيه.
أما على مستوى النظام الاجتماعي فمن آثار الإيمان تحديد الغايات الإنسانية والملائمة فيما بينها فلا يتسبب الانسياق للأهواء في تداخل طرق الناس ومن ثم يحدث العداء فيما بينهم؛ ولذلك فإن الإيمان قادر على أن يوحد بين البشر مهما اختلفوا أو تنافروا إذ أن دوره يقوم على منح النفس ما يساعدها على مقاومة طغيان الحياة ومصاعبها ومشقاتها، فبإمكانه حذف كلٍّ من الزيادات الضارة بالإنسان من بيئته وبالبيئة من إنسانها، ومن ثم فهو يحول بين انقلاب أسباب السمو العقلي فلا تصير من أسباب الانحطاط الإنساني.
وهكذا لا ينصلح حال المجتمع بالتفعيل الجبري لمواد القانون البشري بقدر ما ينصلح بالصحوة الإرادية للضمير الإنساني الذي وضع ذلك القانون كي يُطبَّق عليه. فالإيمان اليقيني المستقر في النفوس هو الذي يدفع إلى إيقاظ الضمائر الغافلة من سباتها العميق فلا يصعب على الجوارح الاستجابة لأوامر الشرع والخضوع لنواهيه طواعية. وها هو القانون الذي يفصل بين كل الخاضعين لسلطته لم يفرض الخير ويحميه إلَّا بالقوة، ولكن سيظل الشر يحتال على تلك القوة للإفلات منها، ومن ثم لن يتوقف طغيان المحتالين على القانون بقوة نفوذهم وثرائهم، ولن ينتهي حقد العاجزين عن تحقيق ما يحلمون به من عدالة بسبب فقرهم وفاقتهم.
فإذا لم يعد هناك إيمان فلن يجد الفقر أمامه سوى التحول عن صورته البيضاء في سكب الدمع إلى صورته الحمراء في سفك الدماء، وبعدما كان الفقر مجرد سؤال مُلحٍّ فسيغدو اغتصابًا قهريًّا، وآنذاك سيفرض نفسه على أنه هو الحق بعدما لم ينجح الحق في أن يفرض على الأغنياء التعاطف معه وتلبية احتياجاته.
فمع اختفاء الإيمان ستختفي التقوى وستغادر النفوس مصطحبة معها الرحمة والصبر، فإذا ما عمَّ الاضطراب والتصادم بسبب تضييع التوازن المطلوب بين الأغنياء والفقراء فحتمًا سيتم فقدان بوصلة الاتزان في المجتمع وسيدفع طغيان العلم والمادة في ظل الإلحاد إلى هدم الجُدر بين كل ضديْن من أحوال الإنسانية، وستترك المدنية قوة الإيجاب في طبيعة الحياة بغير قوة قلبية سلبية من الإيمان في طبيعة النفس؛ ومن ثم ستتعاظم قوة الشهوات التي ستلح على الإنسان الفقير بالغِنى والثراء كي ينال المتع المحروم منها حتى لو كان ذلك الغِنى بطريق غير عفيف ليجد نفسه في نهاية المطاف قد فقد إنسانيته وأخلاقه وطهره من أجل التخلص من الفقر والاحتياج.
وأخيرًا يطرح الرافعي السؤال الذي عنون به مقاله متسائلًا: هل سينحدر الإنسان من عصر عقله إلى عصر معدته أو (شهواته)؟ وهؤلاء الأغنياء الذين يعانون من فقر الإحساس وغيرهم من المساكين الذين نفذ صبرهم وفقدوا إيمانهم كيف سيكون حالهم كلما اتسعت الهوة فيما بينهم؟ ففي ظل الإلحاد لن تنجح المادة في إعادة الحياة للقلوب الميتة بل إنها لن تزود أصحابها سوى بالأظافر القادرة على انتزاع لذتها كي يتم إطلاق سراح شهواتها.
وبالفعل بدأ الاستشعار باليوم الذي تنبأ به الرافعي منذ قرن مضى، والذي سيكون فيه أعظم اختراع للإنسان هو أن يعيد إلى الأرض إنسانها الأول الكريم.
إن الرافعي يتحدث عن هذا النوع من الإيمان الذي يخاطب الناس جميعًا بأنهم هم الفقراء إلى خالقهم وأنه هو وحده الغَني الذي يُحمَد سواء في حال الفقر أم في حال الغِنى، وهو لا يساوي فقط بين الناس بعدالة مطلقة، أو يبعث اليقين في القلوب بوحدانية الخالق؛ ولكنه أيضًا يمنح الفقراء في المال والمساكين والمحتاجين العزة التي بخل بها عليهم الأغنياء ممن احتقروهم واستهانوا بهم بسبب ظروفهم القاسية، وذلك عندما ساوى بينهم وبين الأغنياء عند خالقهم وموجدهم ومُقسِّم أرزاقهم. كما إنه بهذه المساواة قد ألقى في ضمائر الأثرياء والمقتدرين معنى التواضع لمن هم أقل منهم مالًا والرحمة بمن هم أضعف منهم حالًا.
ومن هذا الإيمان ينبع اليقين والاستبشار بقدرة الخالق على تغيير الأحوال من الفقر إلى الغِنى، كما تتولد التقوى سواء في حال الغِنى أم في حال الفقر. ومن اليقين والتقوى سيكون هناك الرضا بكل حال خاصة مع الاستمرار في حمد الوهاب الرزاق والمعطي بلا حساب. آنذاك تتحول النقمة إلى نعمة لأنها ستبعث على الشكر في الضراء مثلما سيوحي العطاء بالشكر في السراء.
فمع صدق الإيمان وقوة اليقين سيهون كل ألم للفقراء وستتضاءل كل لذة للأثرياء لأن كلًّا منهم سيجد في تخلصه من سجن الألم وفي تحرره من قفص اللذة السعادة التي لا يستشعر معناها سوى المؤمن.
وهكذا يكون الرافعي قد قدَّم لكلٍّ من الفقراء والأثرياء الإيمان كحلٍّ وحيد ليس فقط لمشكلة الفقر؛ بل أيضًا للتخلص من كل ألم، وللتحرر من أسر الدنيا القابضة بفتنها وزينتها على رقاب الناس منذ بدء إدراكهم وحتى لحظة مغادرتهم الحياة.