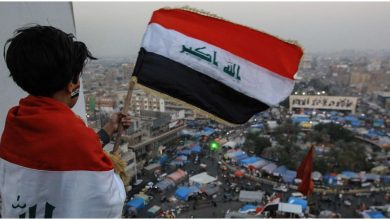في ظل تسيُّد الهُوية الجماعية، وتسلُّطها على استقلالية الهُوية الفردية – يكون من العسير على الفرد التمتع بكامل حريته، أو الحفاظ على هُويته المستقلة، أمام هُوية العائلة وسلطة الآباء والأمهات، وكذلك أمام هُوية الأنساب والأعراق، وهُوية الثقافات والديانات والمعتقدات، وهُوية الأعراف والتقاليد والعادات، وهُوية التاريخ والتراث والجغرافية واللغة، وهُوية كل من النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ بل وأمام هُوية العولمة بكل ما تفرضه من ذوبان تام، في المنظومة العالمية المهيمنة على الجميع بلا هوادة، والمتحكمة في حياتهم بلا مراجعة، والمكبلة لحرياتهم دون أمل في الفكاك من حيل غوايتها وإغوائها.
ويبدو أن الوعي والتساؤل الواعي حول الهُوية الفردية؛ ليسا في متناول الناس جميعًا، خلال رحلة حياتهم القصيرة! وما دام الوعي قد صار من قبيل الرفاهية الإنسانية، بالرغم من توفر سُبل المعرفة وسهولة الحصول على المعلومات أكثر من ذي قبل، فذاك يعني أن الكثيرين -حتى في المجتمعات المدنية- سيعيشون جُلَّ حياتهم، يأكلون ويشربون ويتكاثرون؛ ثم يموتون مكتفين بحياة الأبدان التي تشاركهم فيها الأنعام!
فلماذا لم تمنح المدنية والحضارة الحديثة، الإنسان المعاصر حقه الأصيل في الوعي بذاته وبهُويته؟! وكيف لم تزل كل من الأمومة والأبوة، تُرادف الطاعة العمياء؛ خاصةً في المجتمعات السلطوية المستبدة، التي ما زالت فيها الرجولة ترادف الفحولة، وما زالت فيها الإناث -التي تحيا بعيدًا عن كنف الذكور- مهيضات الجناح ومستباحات بدون استحياء؟
وبينما استرجلت نساء كثيرات في مجتمعات أخرى، كان همها الخروج من العباءة الذكورية، إلَّا أن الفاحشة قد شاعت وتفشى الفجور، وأصبح الشذوذ أمرًا مقبولًا، بل إن جسد المرأة العاري، لم يزل سلعة رخيصة معروضة على الملأ لجذب الأنظار.. وكأن عصر الرقيق لم ينتهِ بعد! وللأسف في ظل الإدعاء المتنامي بالتحرر والتباهي المستمر بالحريات المزعومة؛ بات الكثير من العلاقات الأسرية والإنسانية هشا ومشوها وقائما على تبادل المنافع، وتعظيم جم للفائدة والأرباح المادية في تجاهل ملحوظ للفضيلة والفطرة.
لا شك أن الشعور بالانتماء يدفع إلى الطاعة، التي ينتج عنها الاتباع ثم التبعية، التي قد لا يكون لها سقف؛ فإذا بها لا تعرف أية حدود. وبالفعل فإن الأم هي أول مخلوق يجذب الإنسان للانتماء إليه بشكل غريزي وفطري، أولًا لكونها السياج الحامي للجنين والقادر على أن يمنحه الأمان داخل رحمها، ثم لكونها الصدر الحنون على وليدها والتي تظل ترعاه بعدما أمدته بالغذاء منذ ولادته؛ ولذلك لا عجب إذن أن يترتب على ذلك الانتماء الكثير من الطاعة للأمهات، وكذلك للآباء خاصة في مرحلة الطفولة التي هي مرحلة التنشئة والتربية وليست مرحلة الرعاية والاحتضان وفقط.
أي أنه من المعتاد أن تظل طاعة كلا الأبويْن ملازمة للأطفال بصفة خاصة، ولكن في مرحلة المراهقة يتغير هذا الحال؛ فيظهر بعض التمرد لتبدأ الهُوية الفردية في الإعلان عن وجودها، فلا تلبث الأنا في الظهور بوضوح؛ حتى تصادف الكثير من المعوقات التي منها ما يهذب من صفاتها، ومنها ما يقهر تطلعاتها، ومنها ما يحقق لها التوازن والاعتدال، ومنها ما يضطرها إلى التهور والاندفاع.
وهكذا تظل الأنا الفردية تصارع من أجل وجودها، ويظل الإنسان لا يمكنه مقاومة فرديته، بالرغم من نزوعه للتزاوج، الذي ما أن يقود الإنسان إلى التمتع بشريك يؤنسه في الحياة؛ حتى تتحول تلك الثنائية من جراء التناسل إلى ثلاثية ورباعية .. وهكذا، ما يؤدي في النهاية إلى تنامي شعور الفرد بتعاظم الأنا بداخله، بعدما تمكن من التزاوج الذي أتاح له التكاثر، فأصبح له نسل وذرية تحمل الكثير من صفاته، وتخلد اسمه واسم عائلته، وترث ما قد يجمعه من أموال أو يُحصله من سلطة ونفوذ وجاه. وربما يكون هذا الشعور بطول البقاء؛ كافيًا لدى البعض كي تتحقق معه هُويتهم، ولكن يظل هناك من يبحث عن مفهوم آخر للهُوية له قيمة أكبر ومعنى أعمق!
إن تحقق الهُوية الفردية إذا ما أدى إلى التفرد والتميز فسيكون بالقطع هذا الأمر محبَّبًا إلى النفس الإنسانية التي يكمن بداخلها الكِبر بشكلٍ أو بآخر، أما إذا أدى هذا التفرد إلى الانعزال والتوحد والاغتراب عن المجتمع وعن أي مجموع وأية جماعة؛ فسيكون غير مرغوب فيه؛ ولذلك فإن الانتماء إلى المحيط الجماعي والكيان العائلي وإلى طبقة ما أو جماعة بعينها أو حتى إلى مؤسسة ذات سلطة – يكون بلا أدنى شك هو الأضمن لكل من يبحث عن الاستقرار وعدم الخروج عن المألوف والمعتاد؛ ومن ثم عدم خوض أية مغامرة نجاحها ليس مضمونًا بدرجة كافية من أجل تحقيق معنى الهُوية المنشود.
ومثلما يكون من المألوف الالتزام بطاعة الأبوين خاصة في المجتمعات التي ترتدي ثوب التدين، فإنه أيضًا في المجتمعات التي تميل إلى التمدين يتم الاعتياد على نوع آخر من الخضوع، يتمثل في الانقياد للقوانين الوضعية وفي طاعة الكثيرين من: معلمين، ورجال دين، ورؤساء في العمل، بالإضافة إلى كل من له سلطة وسطوة إلى أن تصبح الطاعة في حد ذاتها أمرًا اعتياديًّا وتلقائيًّا لا يحتاج إلى تفكير أو إعادة نظر. ولكنَّ الأبويْن، وهما أوْلى الناس جميعًا بالطاعة، لم تكن التوصية الإلهية في القرآن الكريم بطاعتهما طاعة عمياء؛ بل كان لها سقف وحدود، ويتضح ذلك جليًّا في عِظَة لقمان لابنه بعدم الشرك بالله. فإذا كان الأبوان من المشركين بالله فآنذاك لا يكون من الصواب أن يتبعهما الأبناء عقديًّا من قبيل الطاعة، خاصة إذا لم يتوفر العلم الذي يطلبه العقل المفكر والقلب السليم من أجل الإيمان.
وهذا يعني أن هناك فرقًا بين الطاعة التي تؤدي إلى الاتباع الأعمى دون تفكير أو إعمالٍ للعقل -وهو ما يتميز به الكائن البشري- وبين حسن الصحبة التي تتيح قدرًا وافرًا من المودة والتراحم، دون التعدي على حرية الاعتقاد لدى الآخرين مهما كانوا من الأقربين.
فالأم وهي أحق الناس بالصحبة والأوْلى بالبر والإحسان، لا يعني البر بها والإحسان إليها إلغاء هُوية الإنسان والتي تتمثل قمتها في معتقداته الدينية والإيمانية. وهكذا الأمر فيما يخص طاعة أي إنسان آخر واتباعه دون تفكير، فإذا بالعقل ينغلق على ما فيه مكتفيًا به مهما كان ضئيلًا أو محدودًا، وإذا بكل مُتبِع بانقياد تام يظل تابعًا ذليلًا لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل تقوده الجموع الذي هو جزء منها. ومثل ذلك الفرد الذي قضى على فرديته بيديه؛ أينما توجهه لن يأتي بالخير، إلَّا لقائده الذي يمسك بزمام أمره، والذي لن يُفلته من يده بسهولة. فما هي إذن أهمية الهُوية لكل إنسان؟
إن مفهوم الهُوية –مثلما أوضحه المفكر المصري وأستاذ الفلسفة الدكتور حسن حنفي [1935-2021] في كتابه (الهُوية) الصادر عام 2012، والذي أهداه إلى شهداء الربيع العربي– يتداخل بوضوح مع مفهوم الماهية ومفهوم الجوهر؛ فجميعهم يُعبرون عن كينونة الشيء وأصله ولُبِّه، وهو ما يعني أن يكون الشيء نفسه التي تدل عليه ولا يكون غيره الذي لا يُعبر عنه.
وتلك الكينونة للهُوية الفردية والمجتمعية تتطلب الصدق في فهم الذات وفي التعبير عن مكنونها، كما تتطلب وجود الحرية الكافية للتفكير والتأمل والبحث والتمحيص والنقد والاستكشاف. ولذلك فإن سلب حرية الأفراد هي السبيل الأمثل لتشويه النفس البشرية، وطمس معالمها، ووأد طموحها للتطور، بل وقتل إنسانيتها ببطء. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الجماعة وعلى المجتمع وعلى الأمة.
وبالتالي فإن أعظم ما يُسلَب من الإنسان دون أن يشعر أو ينتبه من غفلته هو حريته الذاتية، التي ترادف وجوده الإنساني وهُويته الفردية. وعملية السلب تلك تبدأ بالتدريج منذ النشأة الأولى للأفراد، حتى وإن كانت تلك النشأة في المجتمعات المدنية، وذلك ما دامت تلك المجتمعات ترسف تحت نير أنظمة حكم استبدادية.
فبدءًا من الأسرة ثم المدرسة يتواصل الاعتياد على الاتباع والانقياد وعدم إعمال العقل أو التفكير بحرية، وما أن يعتاد الطفل على ذلك حتى يألفه، وبمرور أهم الأعوام والسنين في حياة الفتية والفتيات، والتي فيها تتشكل شخصية كل منهم وتتضح صفاتها، فإنه لن يكون من الصعب أن يُكمل كل منهم حياته في الجامعة ثم في العمل على نفس المنوال وذات النهج. ومثل هذا النتاج البشري لن يكون سوى كتلة صماء عمياء في يد كل ذي سلطة، يطمع في تشكيلها كيفما يشاء، ومن ثم تحريكها في أي اتجاه يريده، دون أي قلق من عصيانها أو خشية من تمردها.
فماذا إذا تفجر في النفس الإنسانية على حين غرة الشعور بالاغتراب والانقسام بين ما تكونه بالفعل، وما ينبغي عليها أن تكونه، وبين ما هو سيئ في الواقع ولا يمكن تغييره وما يجب أن يكون أفضل في المستقبل مع العجز عن تفعيله؟ آنذاك يصارع الفرد ما تجنح إليه نفسه من رغبة عارمة في تحقيق هُويتها في ظل كل المعوقات التي تحاول قمعها وقهر طموحها، فإما أن ينتصر الفرد لهُويته ولوجوده الإنساني مستردًّا حريته، أو أن يعلن هزيمته مضحيًّا بحريته في مقابل حياة لا تليق سوى بالعبيد ولا تريح سوى الأنعام.