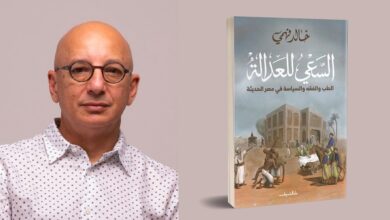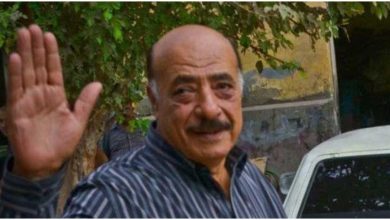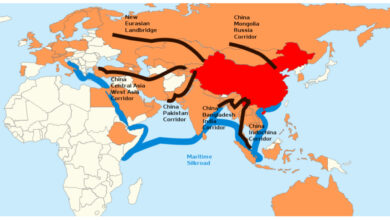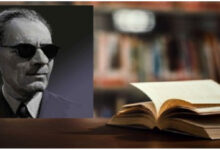إن الوعي والمعرفة هما بداية الطريق نحو الاهتداء إلى معنى الهُوية؛ فبداية استيعاب معنى الوجود ومعنى الهُوية ومعنى الحرية تكمن فيما يُسمَّى بالوعي الذي تشكّله المعرفة ويصقله التعلم، وهو الأمر الذي تميزت به الملائكة من بين المخلوقات، ثم شاركها فيه آدم منذ بداية خلقه؛ ليستمر من بعده مع ذريته وفقًا لما أخبر به التنزيل الحكيم من رب العالمين.
أي إن الهُوية تعتمد بالأساس على الوعي؛ فالوعي الخالص –كما يصفه المفكر المصري وأستاذ الفلسفة الدكتور حسن حنفي [1935-2021] في كتابه (الهُوية)– هو هُوية خالصة، وهو وعي ذاتي لا صلة له بالبدن بل يتعلق بالنفس الإنسانية ذات القبس النوراني المُسمَّى الروح، والذي معه لا يتمايز البشر بأعراقهم أو سلالاتهم أو أنسابهم أو جيناتهم الوراثية أو ألوانهم؛ ومن ثم لا يتفاضلون بانتماءاتهم لحدود جغرافية ما، أو لثقافات غربية أو شرقية، أو أديان سماوية أو ديانات وضعية، أو طوائف دينية أو فرق ومذاهب شتى.
فتلك الهُوية القائمة على الوعي هي هُوية لا تعرف طريقًا للتعصب أو سبيلًا للاستعلاء والتكبر، بل تسلك طريقًا واحدًا لا يعرف سوى المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات في إطار تحميه الحرية وتصونه العدالة. وما دام هناك إيمان بمعنى المساواة بين البشر؛ فلن يكون هناك مجال لتقديس البشر من قبل بشر آخرين مثلهم. وآنذاك إما أن تتضخم النرجسية البشرية الفردية فيتمرد الإنسان على القوة الإلهية الخالقة له وللكون، أو أن يذعن بوجود خالقه ويؤمن بتفرد صفاته وعظمة قدرته مما يعني إقراره بوحدانيته وخضوعه لسلطانه وتسليمه بعبادته وحده دون شريك له.
وفي البداية لابد أن يوجد الإنسان أولًا وتكون له حياة كي يُطلَق عليه كائن حي، ثم بعد ذلك يتشكل وعيه بذاته وبالعالم المحيط به وبماهية حياته والمعنى من وجوده؛ ومن ثم يجد نفسه في مواجهة حاسمة مع وعيه بهُويته وكينونته وذاتيته. ويبدو أنه ليس هناك ما هو أصعب من البحث عن الهُوية وتحديد ما يميزها غير محاولة الحفاظ على ملامح تلك الهُوية والإصرار على فرض وجودها.
ولذلك فإن ما يلي الوعي والمعرفة هو الإيمان واليقين بأن التمسك بالهُوية لابد أن يقود إلى البذل والتضحية من أجلها، فإما التحلي بالصبر والشجاعة والصمود أو التخلي عند أول عقبة ومع كل صدمة. أما الحال الأسوأ من التمسك بالهُوية أو من التفريط فيها فهو أن يظل المرء في حيرة من أمره وفي تردد بشأن وضعه الحالي بين أقرانه ومآله غدًا بعيدًا عنهم، فإذا به بين حينٍ وآخر يُقلّب بصره وقلبه ليقارن نفسه بمن حوله، فيمد تارة عينه في صمت إلى من حوله رغبة في الملذات المتدفقة عليهم، أو يعلن فجأة تذمره المكبوت من كثرة البلايا المحيطة به، والتي لم يعد يقوى على تحملها.
وبمجرد أن يُفضل المرء الحُرية والهُوية على كل ما سواهما من ملذات جسدية، ومكاسب دنيوية زائلة، ومتع شهوانية مُزيَّنة للنفس ومُحبَّبة إليها – حتى يجد نفسه ماضيا قُدمًا وبثبات في طريق وعر ولكنه ليس مظلمًا؛ ومن ثم لابد من عدم التفريط في مصدر إضاءة ذلك الطريق غير الممهد، والذي أهم ما يميزه هو حفاظه على خاصية الاستقامة وعدم الاعوجاج.
إن الانتصار لهُوية النفس الإنسانية النورانية يعني باختصار الترفع عن طينيتها الأرضية وعدم الانجذاب لكل ما يحط من ارتقائها ورفعتها. فلا مجال إذن للتخلي عن قوت القلوب السليمة والعقول المفكرة والضمائر الحية من أجل إشباع الغرائز الجسدية والشهوات الدنيوية، إشباعًا مفرطًا يحكمه الطمع والكِبر ولا يعرف سبيلًا للاعتدال وعدم الإسراف؛ بل يجب أن يكون ذلك الإشباع متوازنًا يميل إلى الترفع والارتقاء دون خضوع أو مذلة.
ومن هنا يتضح أن التمسك بكل من الوعي والحرية من شأنه أن يتنافى مع الالتهاء بكل ما هو خارج حدود الذات الإنسانية، والذي لن يُعوِّض الإنسان عن تحقيق ذاته، بعد التمكن من تقديرها حق التقدير، وكذلك بعد اكتشاف عوالمها، التي قد تظل محجوبة إذا لم يعبأ صاحبها بفهم خصائص تلك العوالم أو محاولة إدراك خباياها.
ومتى استطاع الإنسان أن يتصالح مع نفسه؛ وعى كُنه ذاته وحدد هُوِيَّته التي يريد تحقيقها على أرض الواقع؛ آنذاك سيكون من السهل عليه أن يبني وطنه هو ومن حوله ممَّن يُقدِّرون مدى خطورة المرحلة الراهنة في تاريخ العالم أجمع؛ بعدما سادت السطحية الفكرية، وعمَّ الانحطاط الأخلاقي، وغاب العدل في ظل احتكار الثروة والسلطة.
فكل من يعيش بلا هُوِيَّة فردية؛ لن يصنع أية هُوِيَّة حقيقية لوطنه، سوى تلك الهُوِيَّة الزائفة والزائلة التي تزينها العبارات البرًاقة، وتجمَّلها المظاهر الخدّاعة. فهُوية أي وطن يتقاسمها أبناؤه الذين يستظلون بظل سمائه ويحيون كرامًا على أرضه، قبل أن تعود رفاتهم إلى ترابه.
وإذا كان الوطن ليس مجرد أرض لها حدود سياسية وجغرافية، وإذا كان الانتماء إليه لا يرادف ما هو مُدون في بطاقة الهُوية الشخصية أو في جواز السفر، فإن هُوية الوطن تساوي هُوية أبنائه جميعًا الذين سكنوه وأقاموا فيه ورفضوا الرحيل عنه والارتحال عن ديارهم القائمة على أرضه؛ لذلك إذا تمتّع أهل أي وطن بحريتهم وكرامتهم – فهذا يعني أن بلدهم هذا هو بلد حر كريم، أما إذا فقد المواطنون حريتهم وكرامتهم داخل أوطانهم؛ فهذا يعني فقدانهم لهُويتهم وفقدان بلادهم لهُويتها، ولن يُعوِّض ذلك الفقد الإكثار من إنتاج الأغنيات الوطنية التي تعبر عن أمومة الأوطان وتحث على الانتماء إليها مهما ترددت على الآذان ليل نهار.
فالناس الذين يجوبون كل مكان ذهابًا وإيابًا، في ظلمة الليل وعلى مدار ساعات النهار سعيًا لطلب الرزق، بالرغم مما يتمتعون به من قدرة على الحركة إلَّا أن حركتهم تلك ليس ضروريًّا أن تكون لها ثمار نافعة مهما كثر عددهم؛ بل إن غيرهم ممن يتحركون بقدر ملحوظ من الحيوية والحماس وممن لديهم وعي بهُويتهم وأهدافهم وقيمة حياتهم هم فقط الأكثر قدرة على العمل الإبداعي وعلى الإنتاج الخلَّاق مهما قلَّ عددهم.
ولكن للأسف هناك الكثير من المجتمعات التي ترضى لغالبية أفرادها بحركة ظاهرية غير فعَّالة، ومُسيَّرة في واقعها وغير مُخيَّرة، ولا ينتج عنها سوى المزيد من الخنوع والاستسلام بعيدًا عن اغتنام الحرية وعن إعمال العقل! وهؤلاء الغالبية لا ينفك أن يتحكم في حركة حياتهم قلة من المنتفعين بصمتهم عن حقهم في نيل حريتهم وتخليهم عن تحقيق هُويتهم الإنسانية. وإذا كانت سلطة هؤلاء على الأغلبية قد اكتسبوها من ثرواتهم ونفوذهم فإنهم لن يفرطوا فيها بعدما حدَّدوا هم هُوية وجودهم؛ فاختاروا أن يكون صعودهم قائمًا على أعناق الضعفاء والمقهورين.
ولكن إذا كان الإنسان ينشد الصلاح للأرض، فعليه أن يعي أن الهُوية الفردية والجماعية، لا يمكن لأي منهما التحقق في ظل القهر والكبت أو الانفلات والانفتاح بدون وعي. فمثلما يؤدي القهر والتسلط على المستويين الفردي والجماعي إلى التقزم والانكماش والعجز والإحباط؛ فإن التسيب والانفلات يقودان بدورهما إلى الانحراف والشذوذ والخواء والضياع. وكما أن الانفتاح على العالم الخارجي لا يعني الذوبان فيه انبهارا بتقدمه السريع؛ فتضيع الهُوية الخاصة بالفرد وبالمجتمع بعد تشويهها وتمسيخها، فإن الانغلاق على الذات وتجنب أي إصلاح مطلوب – هو أيضًا لا يعني سوى التخلف عن مواكبة كل تقدم والاكتفاء بما كان والاستغناء عما يجب أن يكون إلى أن تَبلى الهُوية الفردية والمجتمعية ويصيبها العطب والضمور.
ولذلك في سبيل الحفاظ على دعائم الهُوية الإنسانية السوية التي هي أساس الهُوية المجتمعية فإنه لا مناص من تنشئة الأجيال الجديدة منذ صغرهم على عدم الخضوع الكلي والطاعة العمياء لكل ذي سلطان، بل وتنمية القدرة على تحدي الصعاب والضغوط، وعدم الاستسلام لكل ما يسلب من الفرد قوة عزيمته واستقلاليته، أو يعوق حرية تفكيره، أو يصيبه باليأس والقنوط. هذا بالإضافة إلى عدم الاعتماد كليًّا في سبيل التمتع بالحرية على العقل والعلم في مقابل إهمال الضمير والتخلي المفرط والمتعمَّد عن الفضيلة والأخلاق.
وإذا كان المكسب والربح هما أهم ما يسعى إليه الإنسان في كل زمان ومكان، فإنه معروض أمام البشر جميعًا مكسب عاجل زائل يحمل خيرًا في الظاهر ولكنه يخفي الكثير من الشر، بينما هناك مكسب آخر آجل ودائم ليس فيه شر ولكن ثمنه ليس بمقدور الجميع؛ بل لا يسعى إليه سوى فئة خاصة من البشر اختارت الجهاد في سبيل إنسانيتها وكرامتها وحريتها بعدما أيقنت أن تلك هي هُويتها.
ومن الطبيعي أن يُفضِّل الإنسان المادي كل مكسب عاجل مرئي وملموس، وأن يسعى غير الماديين من البشر إلى المكاسب الروحية والمعنوية، ومثلما يرى أهل الدنيا أن دنياهم هي كل شيء، وأن أبدانهم هي الأوْلى بإفناء حياتهم من أجلها، فإن أهل الدين الذين يؤمنون بالغيب عن ظهر قلب، يرون عالمًا غيبيًّا غير عالم الدنيا ويدفعون من أجله حياتهم الدنيا ثمنًا له، ولأنه ليس ثمنًا زهيدًا فإنه لا يقدر عليه سوى من أدرك أن نفسه ثمينة بحق، وأنها تستحق أن تحيا حرة وأن تموت في سبيل حريتها.
وهذا هو المكسب الذي يمكن أن يجنيه الفرد إذا تحدَّى كل ما يحيط به من بنى سلطوية مُستَحْكَمة ومُتحكِّمة في كل شيء بكل ما لها من جبروت وطغيان .. إنها نفسه الحرة والمُكرَّمة بسبب حريتها في الاختيار، والمُثابة على عمل الخير، والمُعاقَبة على سوء عملها –إذا كانت تؤمن بالبعث والحساب، والتي تتجلَّى قوة إيمانها الغيبي، في يقينها بهوان كل بنية سلطوية -مهما كانت مستبدة- أمام مالك الملك وصاحب الملكوت، الذي سيعود إليه الجميع فرادى مثلما خلقهم أول مرة.
فإذا ما تمكن الإنسان العاقل من تحديد معالم هُويته الفردية وتبصر بحدودها، وأيقن أن نفسه في الأصل حرة في اختياراتها، وفي عملها قولًا وفعلًا، وأنها في ذات الوقت مسئولة عن اختيارها وعن عملها، فهذا يعني أنه من الوارد أن تُحاسب تلك النفس على كل كبيرة وصغيرة فتثاب أو تعاقب، وبالتالي لا مهرب من تحمل نتائج كل عمل تقوم به النفس ما دامت متمتعة بحريتها. وبقدر إيمان الإنسان بأن هناك حساب على عمله الدنيوي وأنه لن يضيع هباءً – بقدر ما سيحافظ على هُويته دون تفريط فيها؛ خاصة إذا تمكّن من تحديد غايته من حياته، وباتت تلك الغاية واضحة أمام عينيه بلا أدنى لبس أو تعتيم.
وهذا هو الاستمرار المثمر لمعنى الهُوية الفردية فهو ليس معنى مؤقتًا زائلًا بل هو معنى خالد أبدي، وبقدر ما يمنحه للإنسان من تفرد وتميز؛ فإنه أيضا يضع على عاتقه مسئولية اختياراته في الحياة، ومسئولية ما يعمله. وفرديته تلك التي يجاهد من أجلها ويُضحى في سبيلها – هي التي ستُترجَم إلى عمل قد يمنحه السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي.
فإذا لم يستعلِ الإنسان بتلك الفردية؛ فيزين له كبرياؤه تفرده وتميزه على من غيره من البشر، فلن يتجبر أو يطغى في الأرض، ولن تسول له نفسه الأمارة بالسوء أنها من الممكن أن تتحدى خالقها، فتفلت من عقابه إذا ما أفسدت في الأرض أو ظلمت أحدًا من خلقه؛ ومن ثم فمن واجب كل نفس إنسانية حرة، بل ومن صميم عملها، أن تنشر العدل وأن تقف في وجه البغي والظلم، وتلك هي أجلّ مهمة لها ما دامت تبغي الخلافة في الأرض.