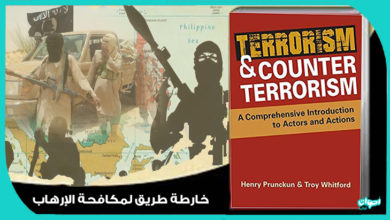إذا كانت السنة لغة، كلمة اشتقت من “سنّ” بمعنى بين وسهل وأجرى؛ وإذا كان اللغويون قد فرقوا بين معنى “سن الأمر” بينه، وبين معنى”سن الشيء” سهله.. يمكننا التأكيد على القول، بأن معنى “السنة”، وهي اسم من المصدر، هو النهج والطريقة والسيرة والعادة. وعليه، فالسنة (المحمدية) تعني تبيان وتوضيح أحكام الله عز وجل كما جاءت في كتابه، وطريقة الرسول (ص) ونهجه في عملية هذا التبيان والتوضيح.
ولعل ذلك التأكيد، ينبع ليس فقط من التمايز الذي ورد في إطار النسق القرآني، في ما بين السنة الإلهية وبين سنة الرسل و/أو الأولين، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: “سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا” [الإسراء: 77].. ولكن أيضًا من السياق الذي وردت فيه كلمة “سُنَّةَ” في نسبتها إلى الأولين، وذلك كما في قوله سبحانه: “قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ” [آل عمران: 137].. وكما في قوله سبحانه وتعالى: “وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا” [الكهف: 55].. وكما في قوله تعالى: “يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [النساء: 26].
معنى السنة النبوية
السنة إذن، وبكلمة هي “النهج” والسنة (المحمدية) هي نهج الرسول (ص) في تبيان أحكام الله عز وجل كما جاءت في كتابه العزيز. وهو أي: محمد بن عبد الله، عليه الصلاة والسلام، في نهجه هذا، كان، وما يزال، وسوف يظل، لنا فيه “أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ”.. وذلك كما في قوله جل جلاله: “لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا” [الأحزاب: 21].
بيد أن الأمر الجدير بالانتباه هنا، أن “السنة” قد علقت بالأذهان ليس بكونها “نهجًا” انتهجه الرسول (ص) ـ من حيث كونه “رسولًا” ـ في تبيان وتوضيح أحكام الله عز وجل كما جاءت في كتابه الكريم، فاستحق ـ بهذا النهج ـ أن يكون لنا فيه (لاحظ دلالة حرف “في” كما وردت في سياق الآية)، “أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ”، هذا لمن كان “يَرْجُو اللَّهَ” و”الْيَوْمَ الْآخِرَ”، و”ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا”.. لكنها (أي: السنة) قد علقت بالأذهان:
أولاً، بكون “السنة” تتضمن أفعال وأقوال وتقارير الرسول (ص) معًا، وذلك اعتمادًا على قوله سبحانه: “وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا” [الحشر: 7].. وقوله تعالى: “قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ” [الأنبياء: 45].
ثانياً، بكون “السنة”، هي من “الوحي”، وذلك اعتمادا على قوله عز وجل: “وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى” [النجم: 3 ـ 4].
هذان المعنيان لـ”السنة”، لم ينتشرا وينالا حظهما من الذيوع حتى أصبحا عالقين بالأذهان، أذهان بعض محاولي التفسير وتأويل النصوص من المحدثين، إلا كـ”نتيجة” للعديد من أقوال ممن سلف من “المجتهدين”.
ولكثرة هذه الأقوال، سنكتفي بالإشارة إلى أمثلة من نصوص المتبوعين، وليس التابعين..
فالشاطبي، كمثال، يشير إلى أن: “الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول (صلى الله عليه وسلم) مختبر بوحي صحيح…” (الموافقات للشاطبي: 4/21، 29).. وابن حزم، كمثال آخر، يكتب مؤكدًا: “ووجدناه عز وجل يقول فيه (أي: في كتابه الكريم) واصفًا رسول الله: “وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى”، ما فصح لنا بذلك أن الوحي من الله عز وجل إلى رسوله ينقسم على قسمين: أحدهما، وحي متلو مؤلف تأليفًا معجز النظام، وهو القرآن. والثاني، وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز ولا متلو، وهو الخبر الوارد عن رسول الله” (الإحكام لابن حزم: 1/108).. والغزالي، كمثال أخير، يقول: “ولكن بعض الوحي يتلى فيسمى كتابًا، وبعضه لا يتلى وهو السنة” (البحر المحيط للذركشي: مخطوطة مكتبة تيمور بالقاهرة، برقم 101، أصول الفقه، ج1، ورقة 97).
ولعل أول ما يمكن ملاحظته على هذا الإطار، بما يتضمنه من معان ودلالات بعينها لـ”مفهوم السنة”، أن هذه الدلالات وتلك المعاني قد رُتبت على “اجتزاء” بعض من الآيات الكريمات من السياق العام الذي وردت فيه.
مقاربة مفهوم السنة
ولننظر إلى قوله سبحانه وتعالى: “وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى” [النجم: 1 ـ 5].. هنا ينبغي أن نلاحظ، بل ندرك، أن كلمة “يَنْطِقُ” ليست من صيغ العموم ـ حتى نتمكن من القول أنها تشمل الكتاب والسنة ـ ولكنها وردت مخصصة، وذلك من خلال إدخال “ما” الحرفية عليها.
فهو تعالى قال: “وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى”، ولم يقل: “ولا ينطق عن الهوى”. فـ”ما” الحرفية، هنا، دخلت على الفعل المضارع فخصصته للحال. قامت بذلك بالرغم من انتفاء القرينة في هذا المقام. وبناء عليه، فإن كلمة “يَنْطِقُ” قد جاءت مخصصة. وأن تخصيصها جاء للدلالة على أن: ما كان رسول الله (ص) يقدمه من آيات كريمة، شكلت بمجملها كتاب الله سبحانه وتعالى، هو “وَحْيٌ يُوحَى”، وأضحى الضمير “هُوَ” عائدًا إلى ما كان “يقدمه”، أي “ينطقه”، أي “آيات الله”.
أضف إلى ذلك، أن ما ورد في الآية الكريمة هو فعل “النطق” وليس فعل “القول”، وذلك لارتباط فعل “النطق”: ليس فقط بمعنى أبان وأوضح، ولكن أيضًا بمعنى الأدلة. فكأن الله سبحانه وتعالى قد أراد تنبيه أذهاننا إلى الدليل في أن: “ما ينطقـ”ـه الرسول (ص)، من آيات الله عز وجل، إنما ينطقه: ليس “عن الهوى” بدليل أن ما علمه إياه “عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى”.
ولعل هذا يتبدى واضحًا إذا لاحظنا، من جانب، حرف العطف (الواو) التي وردت مرتين، ودلالات هذا الورود، في قوله سبحانه: “مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى”.. ولاحظنا، من جانب ثان، أن لا علاقة للضمير “المستتر” في الفعل “ينطق” العائد إلى رسول الله (ص)، بالضمير “هُوَ”، العائد إلى الكتاب المنزل، في قوله تعالى: “إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى”.. ولاحظنا، من جانب ثالث، الدورة الدلالية لفعل “النطق” في النسق القرآني، كما وردت في الآيات [الذاريات: 23، المؤمنون: 62، الجاثية: 29، فصلت: 21، المرسلات: 35].
هذا، بالإضافة إلى أن هذه الآية: “وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى”، كانت قد جاءت في مكة، في مرحلة كان العرب يشككون فيها في “الوحي نفسه”؛ إذ لم تكن المشكلة، حينذاك، هي مشكلة أفعال النبي وأقواله، ولكنها كانت مشكلة القرآن نفسه، والمشكك فيه من قبل معظم العرب. أي إن “الوحي” كان هو موضوع التساؤل والشك، وليس سلوك النبي الشخصي.
هذا عن الآية الكريمة: “وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى”.. فماذا، إذًا، عن الآية الكريمة: “قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ”(؟)… يتبع.