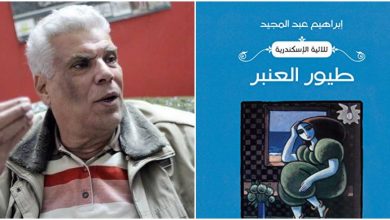في هذه الأيام من كل عام، يجتمع المسلمون من شتى بقاع الأرض، مرددين صيحات التلبية لرب العالمين؛ إقرارًا بوحدانيته وتكبيرًا لعظمته، لتتجلَّى معها معاني التسليم لمالك المُلك، في قلوب خشعت لذكر الله عز وجل؛ خضوعًا لمُلكه وإجلالًا لملكوته، بعدما تلاشت وتبددت أية ظنون أو شكوك حول خالق الوجود وقدرته.
ومع اليقين الباعث على الطمأنينة، تتوالى صيحات التلبية على أرض مكة “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك”.. فإما أن تكون تعبيرًا صادقًا عن الاستعداد للتضحية والبذل، في سبيل الحق بعد الاهتداء إلى الصراط المستقيم، أو تكون مجرد عبارات جوفاء؛ يختفي صداها بمجرد الانتهاء من مناسك الحج التي أدّاها خاتم الأنبياء والمرسلين، فكانت بمثابة فتح مبين للمسلمين وانتصار لدين الحق، على كل شرك وضلال وبغي، فهل ما زال الحج إلى بيت الله الحرام يجمع المسلمين قلبًا وروحًا وعملًا وبذلًا من أجل تحرير بيوت الله التي دنسها أعداؤه، أم إنه بات مجرد مناسك تؤديها مئات الألوف من الأجساد المجتمعة في مكان واحد، دون أن تعكس وحدة المسلمين أو عزتهم؟!
إن الإيمان يلزمه هداية، واستمرارية الإيمان ودوامه، بحاجة إلى تجدد تلك الهداية؛ ولذلك كان الإيمان والهداية متلازميْن، وكان الاتباع نتيجة للإيمان الذي يقوى ويترسخ بتجدد الهداية والذي لا يمكن أن يكون مُلزِمًا بكل ما فيه من قيود وضوابط، بدون علم يتميز به المُتَّبَع ويحتاج إليه المُتَّبِع.
والاتباع يعني الامتثال لكل أمرٍ ونهي وهو ما يرادف الطاعة التي بمجرد أن يرتضيها المرء لنفسه؛ فلن تلبث إلَّا أن تتحول إلى أمرٍ معتاد لا يشغله التفكير فيه أو إعادة النظر بشأنه. ولذلك من الأولى أن يدرك كل مؤمن حقيقة اتباعه، ومن الذي يتَّبِعه، وأي شيء يتَّبِع.
وإذا كانت معاني كلٍّ من الألوهية والربوبية لخالق الإنسان ومبدع الأكوان – تتجسَّد في كل أمر ونهي، وإباحة وتحريم، وعصيان وتوبة فتتسامى وحدانيته التي لا تقبل أدنى شِرك، وتتجلَّى ربوبيته التي تغمر عباده بالرحمة والغفران، فإنه ما دام هناك إيمان لا يشوبه كفر فلا عجب إذن من التزام الطاعة واجتناب الآثام.
فمنذ أن صدر الأمر الإلهي لآدم (أبي البشر) وزوجه بسُكنى الجنة وإباحة الأكل منها – كان ملازمًا لذلك الأمر ومعطوفًا عليه عدم اقتراب كليهما من شجرة بعينها؛ فكانت الإباحة أوسع بكثير من التحريم، ولم يكن المنع يمثل سوى القليل من كثير؛ ومن هنا اقترن الإنسان بالقدرة على الاختيار التي مثلما تستلزم مقدرة على التعقل والتفكير والتروي؛ فإنها أيضًا تتطلب حرية إرادة وقوة عزيمة وتهذيبًا للنفس، وهذا هو ما يتميز به الإنسان عن كثير من المخلوقات؛ ومن ثم من البديهي أن يكون لحياته معنًى يتسم بالسمو ما دام قد أدرك أنه مخلوق مُكرَّم ومُفضَّل.
ولأن الغفلة ليست بعيدة عن آدم وبنيه، ولأن الوقوع في شَرك الغواية والإغواء ليس منه عصمة أو مفر – تمحيصًا للإيمان ومدى صدقه، وتمييزًا للصادقين فيه عن الكاذبين والمنافقين– فقد كانت الغواية قضاءً محتومًا قدَّره الإله الحكيم القادر، على أن يكون في كل أوامره رفق، وفي كل نواهيه رحمة، مثلما هو كرمه بلا حساب. ولأنه ليس هناك من هو أعظم رحمة منه بمن عصاه، فقد أنعم على عباده الأوابين بالتوبة، ومنَّ على كل مذنب بالعفو والغفران.
ولا شك أن المؤمن الذي يطلب من ربه الهداية والرشاد في كل ركعة من ركعات صلاته المتكررة عدة مرات في كل يوم وليلة – من شأنه أن يكون أكثر حرصًا على الاستقامة ممن سواه، خاصة وأنه يتوجه في صلاته تلك إلى إله رحيم، ما أن أمر عباده بالاستقامة، وهي ذلك الأمر الصعب الذي يعتمد على الاختيار بين المباح والمحرَّم، حتى أرشدهم إلى مداومة التضرع إليه سرًّا وجهرًا من أجل طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، كما بشرهم أيضًا بالمغفرة والتوبة إذا ظلموا أنفسهم بعصيانه.
وإذا كان الإله الخالق بيده ملكوت كل شيء، وإليه يُرجَع الأمر كله، فلابد إذن أن تكون طاعته في كل أمر ونهي مُلزِمة، لمن يؤمن به وبمنهجه وتكاليفه يقينًا في حكمته ورحمته وتسليمًا بقضائه اللطيف العادل. وبالتالي فإن توحيد ذلك الإله يعني الالتزام بطاعته وحده دون شريك، والاتكال عليه وحده دون وسيط، والخضوع له وحده دون التماس شفاعة من وليّ أو محاولة لتقديس مخلوق بشري. ولذلك كان الحمد والتكبير متلازميْن ويدلان على التسليم لرب العالمين، ويوحيان بتفرده بالتعظيم والامتنان لفضله ونعمه بلا كنود أو جحود أو نكران.
ومما لا شك فيه أن الإيمان مسئولية وتكليف وليس تشريفًا يترتب عليه التباهي والاستعلاء، أو الركون إليه تكاسلا عن العمل. وها هو الهوى قادر على إخضاع رقبة كل ذليل لسلطانه؛ لذلك يجب أن يحذر منه الإنسان أشد الحذر. فكم من سمع أشبه بالصمم، وكم من حضور أشبه بالغياب، وكم من طاعة تتكلفها الجوارح ولا تنفذ فوائدها إلى صميم النفس بسبب اتباع الهوى الذي يوسوس به الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس.
إن سلامة القلوب التي تتفتح بسببها الآذان؛ فتعقل ما تسمعه هي النقيض لفسادها الذي بسببه تبدو الآذان وكأنها تعاني من الصمم، حتى وهي سليمة وقادرة على السمع. كما أنه إذا ما عميت القلوب فلن تكون هناك أية فائدة من إبصار العيون مهما بلغت حدة الإبصار؛ فسلامة القلب ترادف استعداده لاستقبال تيار الهداية من الخالق الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو وحده القادر على تخلية القلوب وتنقيتها وتخليصها من كل شر يتمكن منها أو غواية تضللها أو هوًى يطغيها.
ولذلك فإن عبارة “اهدِنا الصراطَ المستقيم” ليست مجرد دعاء عابر مُكوَّن من ثلاث كلمات هينات يكررها المسلمون في صلواتهم التعبدية كل يوم وليلة عدة مرات؛ بل هي أكثر من ذلك بكثير، فهي أهم دعاء للمسلم يدعو به ربه متضرعًا إليه في تكرارٍ لا يتوقف طوال حياته من أجل أن يمن عليه خالقه بالهداية.
فأية هداية تلك التي يرجوها الإنسان المسلم من ربه وهو مسلم بالفعل، بل ويؤدي العبادات والطاعات التي تم تكليفه بها؟! وما هي خطورة الاتباع بدون علم، والتبعية بكل انقياد، والتعظيم والتفخيم لكل ذي سلطان والخوف من بطشه في تجاهلٍ تام لتلك التلبيات التي يرددها المسلمون جميعًا بأن الله أكبر وأنه هو الإله الواحد الذي لا شريك له؟